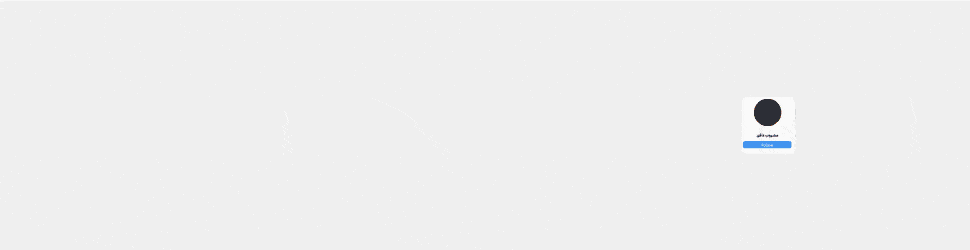تقرير ايمان محاميد
تصوير وائل عوض
يعتبر الفنان عماد الصالح من أبرز الشخصيات الثقافية، الذين أرّخوا بقلمهم وعزفهم ولحنهم للجرح الفلسطيني النازف، منذ بدايته وحتى آخر مرة أمسك فيها القلم، ليسرد روايته التي اصطحبها معه في زيارته إلى حيفا. فهو عازف وملحن ومغن وشاعر، استطاع أن يربط حياته الفنية والأدبية والشعرية بحياة شعبه في مختلف المراحل التي مرت بها القضية الفلسطينية.
وأكد في قصائده وألحانه ورواياته، من خلال المزج بين الرمز والواقع، على التمسك غير المحدود لشعبه بأرضه وموروثه الحضاري، وعلى إرادته الصلبة في الدفاع عن قيمه وحقوقه من خلال قلمه وعزفه ولحنه… العازف والملحن والمغني والشاعر والكاتب الدكتور عماد الصالح.
لماذا أكتب ؟؟؟
– أكتب لكي تلاقي الكلمات فسحة وتجلس فيها…. أكتب من أجل نساء بلادي لكي ينجبن ويلدن أطفالا، دون خوف من أن أولادهم سيموتون قبل ولادتهم… أكتب لأن أطفالنا يحملون حلما، ومناقيش الزعتر في كل صباح، فيحملوها من أجل كل الأطفال، فينطلقون من غزة إلى حيفا بدون جواز سفر…
أنا من جيل ما بعد النكبة، لأني ولدت عام 1949، أما شقيقتي رحاب فهي من مواليد وادي النسناس في حيفا. ولدت في سوريا لأبوين فلسطينيين، والدتي من طيرة حيفا وأبي "أحمد الصالح" أصله من صفد، التقيا وتزوجا في حي وادي النسناس في حيفا، ولا يزال البيت قائما حتى الآن في الواد ولكن شركة عميدار أغلقته لاعتقادها أنه آيل للسقوط، ثمة ارتباط متين وعضوي بيني وبين حيفا لأسباب عديدة، وكان جدي وجدتي، والدي ووالدتي يرددون الحديث الدائم عن حيفا، فكبرنا وترعرعنا على حب حيفا، كيف كانت حيفا، كيف عاش الناس فيها، في شوارعها، في أحيائها، كيف تعامل مع الناس في الحياة الاجتماعية والسياسية. وهكذا أمضينا مرحلة الطفولة وحيفا في صلب حديثنا المركزي. وكذا صفد، الطيرة، حتى أصبح لها مكان مميز في وعينا. وكبر هذا المكان كلما كبرنا، وتأصلت علاقتي بحيفا لأنها علاقة تاريخ وذاكرة، مدينة حيفا ذات الأثر الكبير عليّ وعلى حياتي وإنتاجي.
اللاجئون في لبنان وسوريا عدة فئات، فمنهم الأثرياء الذين اندمجوا في الحياة العامة، ومنهم الذين سكنوا المخيمات، والذين أقاموا في المدينة، وتدهورت الأوضاع في المخيمات وخاصة في لبنان.
وغادرت سوريا بعد سن العشرين، لمتابعة دراساتي العليا في فرنسا، وأثناءها امسكوا وطلبوا مني أن أقوم بالتدريس في فرنسا. ثم حصلت على دكتوراه في علم الاجتماع وعلم النفس من جامعة "تور" الفرنسية، ورغم توفر مجالات العمل الواسعة في هذين الاختصاصين لكني لم أكتف بذلك، وعملت للمعيشة فقط، وبقي الهاجس الدائم يقلقني، إنه فلسطين. وزرتها للمرة الثانية.. وأنا متزوج من فرنسية، والدها من أصل عربي لبناني، وعاشت في لبنان 12 سنة. رزقت بولدين: "لامبير شمس" 21 سنة، وهالة أو ماتيلد 12 سنة.
كيف مارست النضال لقضية الفلسطينية؟
– تعددت سبل النضال الفنية والكتابية، ولا ينحصر الأمر بالمظاهرات والاحتجاجات، ولكن رغبت القيام بأعمال من خلال الفن والكتابة، لأثير إحساس الجمهور الفرنسي بالقضية الفلسطينية، دون التنازل عن هويتي الفلسطينية. ومن خلال الفن والمؤلفات الشعرية والروايات والموسيقى، وغنائي لقصائد محمود درويش، سميح القاسم وتوفيق زياد فعلت ذلك. وكنا نخرج في المظاهرات ونعقد الاجتماعات لأجل شيء لم نره ولم نلمسه، ناضلنا عن فكرة فلسطين، عن الوطن الكامن في أعماقنا، من خلال اتصالنا وتواصلنا بأهلنا، هم حلقة الوصل الذين يجسدون الوطن في حياتي، ابتداءً من جدي وجدتي.
عندما تعيش في الغربة بهدف الدراسة، يتملكك إحساس بالنقص والحنين، تفتقد الأهل والجذور. وعندما دخلت فرنسا حملت وثيقة سفر اللاجئين الفلسطينيين، وفي سنوات السبعين لم يعترف أحد بفلسطين، وأصدرت الوثيقة من سوريا كلاجئ، وهكذا أصبحت تحت العلم السوري، وكثيرًا ما قلت لهم إنني لست سوريا، بل أنا فلسطيني.
وعندما بلغت مرحلة الدكتوراه في الجامعة، كنت أعمل وأدرس في ذات الوقت، ولكي أستطيع إنجاز رسالة الدكتوراه، كنت مرشحًا لنيل منحة من الحكومة الفرنسية للتفرغ لإتمام الأطروحة. ونظرًا لتفوقي وافقوا على هذه المنحة باعتبارها منحة لفلسطيني، وهذا أول إنجاز هام في حياتي، وكان في سنة 1980، وعندها توجهت إلى الجامعة وطلبت تغيير البطاقة على أنني طالب فلسطيني وليس سوري.
– كيف تعاملت مع القضية فنيًا؟
كنت أتساءل دائمًا كيف سأعالج قضيتي الوطنية، رغبت بطرحها أمام الناس، لكي يدركوا من نحن وما هي قضيتنا. وأخذت أعزف الموسيقى منذ نهاية السبعينات أمام الجمهور الفرنسي، وقدمت شعر محمود درويش وتوفيق زياد وسميح القاسم وشعري الخاص أيضا، واعتبرت الفن رسالة نضالية، وخاصة أني لاحظت مؤسسات كثيرة في فرنسا وأمريكا وأوروبا تروج لإسرائيل، ولكن لا أحد يذكر فلسطين وقضيتها. فقررت من خلال اجتهادي الذاتي والفردي، النابع من روح الإنسان وإخلاصه لأهله ووطنه وهويته. وما زاد في قناعتي للقيام بذلك أن ممثلينا في الخارج، وبكل أسف ومرارة، لا يولون القضايا الثقافية أو الاجتماعية أي اهتمام خاص، لكنهم منغمسون في الأمور السياسية.
عليهم تجميع الجالية الفلسطينية في الخارج على الأقل، وفحص كيفية نقل الصورة الواقعية والواضحة عن بلدهم. وعندما يأتي الإسرائيليون إلى البلاد الأوروبية فإن الجاليات اليهودية كلها تدعمهم، وتفتقر فرنسا إلى جالية فلسطينية داعمة، وذات نشاط حقيقي. القضايا السياسية غالبة على القضايا الاجتماعية والثقافية، وثمة تقصير كبير من الفلسطينيين تجاه شعبهم وقضيتهم.
وحتى على الصعيد الشخصي، فإن الفرنسيين يعترفون بي فنانًا محبوبًا ويدعونني لاحتفالاتهم ومهرجاناتهم. ولذا فإن إخلاصي لأهلي وللوطن دعاني ودفعني لكي أساهم بإلقاء الضوء، وإحياء فكرة الشعب موجود ذو التاريخ العريق والثقافة الواسعة بشعره وموسيقاه. وأنتجت حتى الآن أربع أسطوانات، غناء عربي تم توزيعها في فرنسا وأمريكا، وجميع الأغاني مستوحاة من قصائد محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وأشعاري. وتلاقي هذه الأغاني نجاحًا منقطع النظير.
– غنيت مع المغنية الإسرائيلية "سارة الكسندر"
غنينا معا في فرنسا وأمريكا وقمنا بجولة هناك من أجل السلام، مع الإسرائيليين الذين يؤمنون بالسلام وبحق شعبنا بإنشاء دولة فلسطينية. وهدفي من ذلك إظهار الحق الفلسطيني بالأرض والدولة. فالأغاني مبنية على التأكيد على مأساة شعبنا إزاء الدعاية الصهيونية في أوروبا وأميركا، التي تشيع أن إسرائيل تريد السلام ولكن الفلسطينيين والعرب لا يريدونه. فمن خلال مشاركتي مع مغنية إسرائيلية بمصاحبة الكونسيرت الإسرائيلي الفلسطيني أردت القول: نعم نريد السلام المبني على أسس عادلة.
– إنك تخص حيفا بكتاب جديد
ومن ناحية أخرى، فلا بد أن يظهر تأثير متبادل بين المبدع والمحيط الذي يعيش فيه. ولا شك بأن الاغتراب ساهم في صقل شخصيتي. واطلعت في ألمانيا على الأدب الفرنسي والعالمي، وكتبت وصدرت لي ثلاث مجموعات شعرية وقصص قصيرة تناولت فيها القضية الفلسطينية، منها "بين حلمي والقدس"، "أرض الميعاد"، "خمسون عاما من المنفى والأمل" و"صلاة نور". وكذلك قصص قصيرة تتحدث عن حياة اللاجئين في سوريا ولبنان. وثمة كتاب خامس أردت أن يطلع الحيفاويون عليه قبل الفرنسيين، ويتطرق إلى فلسطين وإسرائيل، بعنوان "مصائر تتقاطع بين الجحيم والأمل" هذا الكتاب رواية متواصلة مع أعمالي السابقة ويتضمن أربعة فصول عن حيفا عامة وفصلا عن وادي النسناس، وآخر بعنوان عبد عابدي وحيفا، حيث أتحدث عن وادي النسناس وتاريخه.
الكتاب يخاطب الفرنسيين ليعرفوا ماذا جرى في البلاد أثناء النكبة، وخاصة تهجير العرب من فلسطين، وبعض المقارنات بين ما عاناه اليهود مع النازيين وما عاناه الفلسطينيون في نكبتهم. ويتناول الفصل عن حي وادي النسناس وسكانه وحياتهم. وعندما تجولت فيه شعرت بأصالته وحيويته، ولا بد من التطرق إلى المحاولات لطمس الهوية الفلسطينية، بمصادرة البيوت والأرض. وفصل آخر عن صفد وكيف انتشرت فيها مظاهر العنصرية بعدم تأجير بيوت للعرب.
إن معظم وسائل الإعلام الفرنسية والمسئولين عنها مناصرون للصهيونية، ولا يعرفون الكثير عما يجري هنا. تعرفت على الفنان الكبير عابد عابدي منذ سنة ونصف، ولم أوافق أن تختار أي دار نشر فرنسية صورة الغلاف للرواية ولكني قررت اختيار لوحة لهذا الفنان المشهور، عبد عابدي.
رحاب الصالح …ولوحة ذكريات حيفا
ولدت الدكتورة رحاب أحمد صالح في حي وادي النسناس في حيفا، وتعيش حاليا في الدانمرك وتحمل الجنسية الدانمركية. تخصصت بدراسات الشرق الأوسط واللغة العربية. واهتمامها بقضايا التربية والتعليم، كان من أهم إنجازاتها خلال دراساتها الأكاديمية في سوريا قبل حضورها إلى الدانمرك. وهي تحمل إجازة في الآداب من جامعة دمشق وماجستير ودكتوراه من وسكس كولج للتقنيات في إنجلترا، وحصلت على مؤهلات تربوية عديدة من: وزارة التربية السورية، دبلوم إدارة مدرسية من معهد التربية "أونروا يونسكو"، وأشغلت عدة وظائف: مديرة مدرسة وموجهة مقيمة في مدارس الأونروا في سورية، مدرّسة للتاريخ في وزارة التربية الليبية في طرابلس، صحافية ومذيعة، أستاذة مساعدة باللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة كوبنهاجن في الدانمرك، أستاذة محاضرة في مدارس وجامعات عديدة، وحاليا كاتبة، باحثة، ومؤرخة .
– ما زالت ذاكرة رحاب الصالح تعانق وادي النسناس
خرجنا من حيفا صغار السن ولا نعرف نهائيا ما يدور حولنا، وبما أن الأطفال يشعرون بما يجري حولهم فقد انعكس هذا علينا سلبا، وكنا نعيش في خوف كبير. وحتى الآن أشعر بخوف من الأصوات العالية. صحيح أن الطفل قد لا يستطيع التعبير بالكلام، ولكنه يحس ويتأثر بمحيطه. وأنا اجتزت عدة محطات في حياتي، وسيظهر هذا في كتابي الثاني الذي اخترت له العنوان "من صفد وحيفا مع الحب "، وسيترجم إلى عدة لغات. وسأطرح فيه القصة الفلسطينية، قصتي قصته قصتك إنها حكاية شعب، بكل الظروف التي اجتزناها، وهي ذات الظروف التي عانى منها الشعب الفلسطيني إن كان في الداخل أم في الخارج. وكل منا جندي يكافح ويجاهد في موقع عمله.
بدأت حياتي كطالبة نظرًا لتشجيع الأهل الذين أرادوا المحافظة على الإنسان طالما نحن لاجئون. وحتى لو ضاعت الأرض وخسرنا الوطن، يجب ألا يضيع الإنسان. فلم يبق أمامنا سوى العلم. وتعلمنا دائما أن نعرف القضية وندرك هاجس الشعب الفلسطيني اللاجئ والمشرد. وأعتقد أن الفلسطيني في سوريا يعيش أفضل من أي مكان آخر سوى وطنه. هناك المجالات مفتوحة للعلم، ويتقبله الجميع عندما يحرز نجاحًا علميًا، وهذا ما حرص والدي عليه، أن نتعلم ونصبح أعضاء نافعين في المجتمع الذي نعيش فيه.
تنقلت بين 6 محطات في حياتي حتى استقر بي الترحال في الدانمرك. ولكن محطتي الأولى كانت حيفا حيث ولدت فيها وتنشقت هواءها، ولذا حملتها في روحي ووجداني، وهي ترافقني أينما ذهبت. حيفا تثير تساؤلات عديدة ولا أجد الإجابات عليها، أين كنا وماذا جرى لنا، كيف أصبحنا؟ ولا يزال الماضي حي في نفسي، وخاصة صورة أهلي الذين خرجوا مع بضعة صور فوتوغرافية لحيفا، وأذكر منها صورة الحي الألماني وشارع يافا، وكنت دائما أعرضها ليراها الأصدقاء السوريون. حيفا التي رضعناها مع الحليب، أحتار عندما أتحدث عنها وعن أحيائها ووادي النسناس، لماذا نعيش هنا في الشتات طالما نحن من حيفا ومن فلسطين؟ وحتى الأطفال يتساءلون لماذا نحن هنا ؟؟
عشنا في مدينة حمص وهذه محطتي الثانية وعملت مديرة مدرسة، ومحطتي الثالثة هي في ليبيا حيث مارست التدريس في غرب طرابلس. دخلت إلى ليبيا بوثيقة فلسطينية لاجئة من سوريا، مكثت نحو 3 سنوات هناك، واضطررت للتكيف فيها، وأمضيت أجمل أيامي في ليبيا. أنجبت ابنتين نسرين وميسون ثم انتقلت إلى أبو ظبي للعمل. لأن العمل أمر مهم ومقدس في حياتي، وفي أبو ظبي أنجبت الصبي أمجد.
في هذه المرحلة رغبت بحقيق حلم قديم كان يراودني وهو حب الخياطة والتطريز، فقررت أن أفتح بوتيك ملابس وأخذت أصمم وأخيط الملابس الجميلة، وكنت سعيدة بما أقوم به في أبو ظبي. ثم انتقلنا إلى قبرص، ولأنك فلسطيني ستتعرض دائما لأحداث سياسة تؤثر جدا على حياتك كلاجئ. أقمنا ست سنوات في قبرص، وشعرنا بشيء من الاستقرار رغم أني ما زلت انتقل بوثيقة لاجئ فلسطيني. ولكني قررت متابعة دراساتي في التربية والتعليم، فحصلت على الدكتوراه من إنجلترا , الماجستير الأولى كانت عن "التربية بين الأمس اليوم" والثانية "التخطيط التربوي". وبعدما غادرنا قبرص بلغنا الدانمرك المحطة الأخيرة أو "الحد الأخير"، وأنا سعيدة لأني أحمل جنسية دانمركية، وعملنا نحو عشرين عاما في الدانمرك حتى استطعنا أن نثبت أنفسنا هناك.
قمت في جامعة كوبنهاجن بتدريس اللغة العربية، والدانمركيون يحرصون على نظام أقوى من العرب في قواعد العربية، كالنحو والصرف. وباشرنا العمل فورًا للحصول على جنسية دانمركية لتؤهلنا بالاستقرار ولكي نتمكن من زيارة حيفا، وبفضل ذلك نحن اليوم في حيفا، في موقع مولدي وادي النسناس. أذكر من مرحلة طفولتي أمي التي كانت ترسم لنا حيفا وطرقاتها وبيوتها، وكانت زيارتي الأولى إلى حيفا في عام 1999، وقد عملت مذيعة في إذاعة الشرق لسنة ونصف في قسم الأخبار، وقدمت برامج وثائقية عن فلسطين.
أنا عضو في جمعية الصداقة الدانمركية، وهناك جمعيات ومؤسسات تعنى بالشأن الفلسطيني، وخاصة البيت الفلسطيني، أعكف على وضع كتاب يهدف إلى تعريف العرب في الدانمرك وخارجها عن الدانمرك، وهو بمثابة "رد الجميل" للبلد الذي استقبلنا ومنحنا جنسيته. الهدف العام من الكتاب هو مساعدة العرب داخل وخارج الدانمرك، وإطلاعهم على النواحي الثقافية والعلمية والتعرف بشكل عام على المملكة الدانمركية والمجتمع الدانمركي وتقاليده وحضارته، وكيف اندمج ذلك الشعب مع حضارات الشعوب كلها لأنه شعب غير عنصري.
أشغلتني القضية الفلسطينية على الدوام في دراستي وأثناء عملي وخلال محطاتي التي حاولت فيها أن أحيي قضيتي الفلسطينية. على الإنسان ألا ينسى جذوره وأصوله، ومن أحلامي أن آتي أنا وأبنائي وأحفادي إلى جبل الكرمل لنلوح بعلمنا فوقه، وأن ننظر إلى بحر حيفا الرائع لأن حيفا في بالنا وقلبنا باقية إلى الأبد. وعبر صحيفة "حيفا" أقول للجميع أحبوا بعضكم بعضا، تمسكوا ببلدكم، ابقوا معا واتركوا كل السلبيات، فعندنا قضية واحدة وهدف واحد. حيفا تاريخ وذاكرة، بينما الدانمرك حاضرنا الآن، ولا نعرف ماذا يأتينا في المستقبل، ومن لا ماضي له لا حاضر ولا مستقبل له..