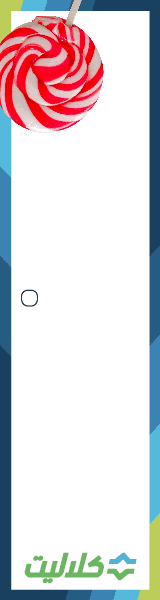.jpg)
سأتطرّقُ إلى تعريفِ الرّوايةِ كجانر أدبيّ
Roman/ رواية: الكلمةُ عُرّبتْ من كلمة "روما"، وهي من اللّغةِ الرّومانيّةِ العامّيّةِ، وليسَ كما يُقال في اللاّتينيّةِ الفصحى، الرّوايةُ فنُّ السّردِ النّثريِّ لمغامراتٍ خياليّةٍ، وتتميّزُ عن الأقصوصةِ مِن حيثُ مداها الزّمنيِّ وغزارةِ الأحداثِ فيها، وإبرازِ صورةٍ كاملةٍ لنفسيّةِ الأبطالِ، وتتميّزُ عنِ الحكايةِ الشّعبيّةِ، بأنّها نوعُ منَ السّردِ المختلَقِ أو المتخيّل، أو تتألّفُ مِنْ مُركّباتٍ وعناصرَ واقعيّةٍ أو وهميّةٍ، حيثُ تُصوِّرُ العاداتِ والأخلاقَ، فيُشيرُ الكاتبُ إلى جانبٍ مِنَ الحياةِ الإنسانيّةِ، ويضعُ شخصيّاتِهِ داخلَ إطارٍ اجتماعيٍّ معيّنٍ، وقد يَشحنُها بغايةٍ خلقيّةٍ أو فلسفيّةٍ أو دينيّةٍ أو سياسيّةٍ أو تاريخيّةٍ أو علميّةٍ، أو مغامرةٍ إنسانيّةٍ تُثيرُ الأحاسيسَ. لذا مِنَ الممكنِ تعريفها: أنّها وثيقةٌ بشريّةٌ مستقاةٌ مِنَ الخيالِ والتّأمّل، ومُمَثِّلةٌ لواقعٍ خياليٍّ أو حقيقيٍّ.
لقدِ اختلفَ النّقّادُ في أصلِ الرّوايةِ، فللرّوايةِ اتّجاهان: بأنّ جذورَها عربيّةٌ، أو لا علاقةَ لها بالجذورِ العربيّةِ، إنّما هي شكلٌ أخذناهُ عن الغربِ. يتّضحُ أنَّ الرّوايةَ الغربيّةَ نشأتْ على خلفيّةِ الأدبِ العربيِّ، والرّحلةُ الّتي قامَ بها الأدبُ العربيُّ بعدَ سقوطِ بغداد، وانتقالِهِ إلى أوروبّا كانَ لهُ الأثرُ الكبيرُ، في نشوء هذا "الجانر" المعروف، وإذا عُدنا إلى تاريخِنا العربيِّ، نجد الكثيرَ مِن بذورِ العربيّةِ، مثلَ أيّام العربِ مِن حروباتٍ بينَ القبائل، حيثُ تواجدتْ قصصٌ وحكاياتٌ عن الزّير سالم، وسيف بن ذي يزن، وعنترة بن شدّاد، وإن اطّلعنا على القصائدِ العربيّةِ، نجدُها تحملُ نفَسًا قصصيًّا مثلَ مُعلّقةِ امرؤ القيس وغيرها.
الخلاصةُ؛ أنّ الجذورَ القصصيّةَ عندَ العربِ قائمةٌ، لكن لم يهتمّ العربُ بها، بل اهتمّوا بالأدبِ الرّسميِّ المبنيِّ على الغزل والحماسة والفخر والمدْح في بلاط الأمراء، ككتاب "ألف ليلة وليلة"، الّذي أدهشَ الغربَ، ومنهُ استمدّ الغربُ مئاتِ القصص.
الرّوايةُ لا تخلو مِنَ الحكايةِ، لكن ليستْ حكايةً عاديةً، إنّما فيها إثارةٌ وتشويقٌ، ومرتبطةٌ بالزّمن والقِيم بينَ الحياةِ اليوميّةِ الزّمنيّةِ، وبينَ حياةٍ في القِيمِ والعودةِ إلى الماضي، أمّا الحكايةُ فتقتصرُ على الزّمن.
ماذا عن هذا الجانر الرّوائيِّ في فلسطين ال48؟
انّ فنَّ الرّوايةِ في أدبِنا المَحلّيِّ ما زالَ في البدايةِ، أي في التّجريب، إذ أنّ معظمَ ما نُشِرَ مِن رواياتٍ تفتقدُ للعنصرِ أو للمُركّبِ الرّوائيِّ الأساسيِّ، لكن قد نتساءلُ:
لماذا هذا الجانر بالذّاتِ تأخّرَ عن الأجناسِ الأدبيّةِ الأخرى كالقصّة والشِّعر؟
هل لذلكَ علاقةٌ بالواقعِ الاجتماعيِّ والسّياسيِّ مَحلّيًّا؟ وهل كلُّ ما نُشِرَ يفتقرُ إلى مُقوّماتٍ عديدةٍ هي الأساسُ في كتابةِ الرّوايةِ؟
تظهرُ على السّاحةِ الأدبيّةِ بينَ الفترةِ والأخرى رواياتٌ، تكادُ تكونُ تاريخًا وتوثيقًا خاليًا مِنَ الدّهشةِ وتَفجُّرِ اللّغة، إذ إنّ كتّاب الرّوايةِ لم يستطيعوا حتى الآن الخروجَ مِن إطارِ الكتابةِ الخطابيّةِ التّاريخيّةِ، وهناكَ مَن يُحيلُ ذلكَ إلى أسبابٍ منها؛ الظّروفُ الّتي يعيشُها الفلسطينيُّ، والّتي أدّتْ إلى إشكاليّةٍ كبيرةٍ في قدرةِ الكاتبِ، بالتّعاملِ معَ الخطابيْنِ التّاريخيِّ والأدبيِّ. لكن، بينَ هذا وذاك نتساءلُ:
أينَ قدرةُ الكاتبِ في التّوازنِ ما بينَ الخطابِ التّاريخيِّ والإبداعيّ؟
للأسفِ الشّديدِ أكثريّةُ الإنتاجاتِ الأدبيّةِ سيطرَ عليها الخطابُ التّاريخيّ، وكانَ ذلكَ على حسابِ الخطابِ الأدبيّ، وهنا تبرزُ هذهِ الإشكاليّةُ بالأدبِ السّياسيّ، بسببِ الوضعِ القائمِ محلّيًّا مِن صراعٍ وعدمِ استقرارٍ، بعد أن ذاقَ شعبُنا الاحتلالَ والتّهجيرَ عبْرَ هذا التّاريخ، ليَحملَ أدباؤُهُ جمراتٍ محترقةً كرَدِّ فعلٍ ودفاعٍ عن القضيّةِ، مِن أجل إلهابِ الجماهيرِ، وتحريكِ نفوسهم العطشى للمقاومةِ والإصرار، وبما أنّ الإبداعَ "فانتازيا" وتحليقٌ بعالمٍ آخرَ متخيّلٍ وساحرٍ، فيدخلُ المبدعُ في حالةٍ بينَ الوعيِ واللاّوعي، لذا؛ ليسَ مِنَ المعقولِ تخطيطُ وبرمجةُ قوانينٍ، ووضْعُ العملِ الإبداعيِّ داخلَ أطرٍ مهندسةٍ، عندَها سيفقدُ العملُ فنّيّتَهُ، ومِن هنا ندركُ أن على المبدعِ أن لا يضعَ أمامَهُ معادلةً للموازنة، بل عليه استشراق الجوانب الكاملة للحدث، ولا أن يكتبَ الحدث كما هو، بل يحاول تكوينَهُ مِن جديد، فينفخ فيه روحًا جديدةً متناغمة، كتعبيرٍ عن أيِّ حدثٍ وكأنّه شاملٌ للحدث، وذلك بالخروج مِن كلاشيه التّقريريّة أو الكتابة الصّحفيّة، وباحتواءِ وإدراكِ ما يكتبُه.
ونتساءلُ.. هل للرّواية في أدبنا المحلّيِّ هُويّة أو بطاقة تعريف؟ وهل دوْرُ النّقدِ سلبيًّا فقط؟
علينا الاعتراف أنّ حركةَ النّقدِ غائبةٌ كقيمةٍ أدبيّة، لأنّ معظمَ النّقدِ في الرّواية هو عمليّةُ استعراضٍ للعمل، أو عدمِ الالتفاتِ لِما يجري في الحركةِ النّقديّةِ في الإبداع المَحلّيّ، وإن تمّ الالتفاتُ فالنّاقدُ لديهِ مِن أسماءِ الرّوائيّين مَن يعرفُهُ ليُبرزَ اسمَهُ، وتُغيّبُ أسماءٌ أخرى في ظلِّ الأسماءِ المعروفةِ والكبيرة، وخاصّةً في شعرِ المقاومةِ، الّذي طغى على الرّوايةِ والقصّةِ القصيرة.
أقتبسُ مِن مقالٍ للكاتبِ والنّاقدِ نبيل عودة في هذا الجانب إذ يقول: "إنّ الكثيرَ مِن أدبائِنا قيمتُهم تكوّنتْ بانتمائِهم وموقعِهم السّياسيّ وليسَ بأدبِهم"! وأضيفُ: إنّهُ مِن مميّزاتِ نقدِنا المَحلّيِّ هو التّأثّرُ بالعائليّة والعلاقاتِ الشّخصيّة، ممّا يفقدُ الكثيرَ مِن مقوّماتِ النّقدِ والصّدقِ الأدبيّ والإخلاصِ المِهنيِّ. وربّما لهذا السّببِ يبتعدُ النّقّادُ ذوو القدراتِ النّقديّةِ مِنَ الولوجِ لمعترك الحياة الأدبيّةِ المَحلّيّة، لذلك؛ صحيح إن قلنا: إنّ أدبَنا المَحلّيَّ يحتاجُ إلى ناقدٍ فدائيٍّ وربّما انتحاريّ، فهل نحنُ أمامَ مهمّةٍ مستحيلة"؟
وممّا تقدّمَ نصلُ إلى القول، إنّ الأحداثَ السّياسيّةَ مِن تقلّباتٍ وتحوّلاتٍ ثقافيّةٍ واجتماعيّةٍ، وأيضًا قلّةِ الموروثِ الرّوائيِّ مِن ناحيةٍ فنّيّة لهذا الجانر في أدبنا المّحلّيّ، ربّما أدّتْ جميعُها إلى ما وصلتْ إليه الرّوايةُ المحلّيّةُ مِن هضم حقّ، أو مِن تعتيمٍ على كتّاب، لو قرأنا لهم وشرّحْنا، وحاولنا كنُقّاد تفكيكَ الرّوايةِ مِن جوانبَ عدّةٍ، وليسَ فقط الموضوع أو فحوى الرّواية.
لا ننكرُ أنّها ظهرتْ على السّاحةِ الأدبيّةِ الرّوائيّةِ إسهاماتٌ قبلَ عام 1948، لكنّها قليلةٌ، لم تُضِفْ للإبداع الحقيقيِّ الّذي كُتب في العالم العربيِّ حينَها. بعدَ الخمسيناتِ ظهرتْ رواياتٌ، لكنّها لم تُشكّلْ مرجعًا فنّيًّا مِن حيثُ المستوى، وحتّى وإن كانتْ ناضجةً، لذا فالجوابُ على بطاقةِ الرّوايةِ، أنّ قلّةٌ مِن الرّواياتِ خرجتْ عن الإطار المألوف، والّتي غلب عليها الخطابُ التّاريخيّ، ولم ترتَقِ بالعملِ إلى التّشويقِ والإدهاش، لذا فالانتقالُ أدّى إلى ركودٍ نقديٍّ، وأيضًا إلى محاولاتٍ أخرى باءتْ بالفشل وعدم الاستمراريّة!
والسّؤال الّذي طرحتُهُ سابقًا عن قضيّة التّوازن بينَ الخطابيْن، هل استطاعَ أدباؤُنا الوصولَ إلى طريقةٍ لا تُغيِّبُ أحدَ الخطابيْن في ظلِّ الآخر؟
للأسفِ.. لا، بل إنّ الصّوتَ التّاريخيَّ كانَ غالبًا في معظمِ الأعمالِ الرّوائيّة، وكأنَّ العمليّةَ الفنّيّةَ تُقتلُ إزاءَ الواقع المُعاش، ولا أدري إذا كانتْ هناك علاقةٌ بينَ عمليّةِ النّضوج عندَ الكاتب، كي يصلَ إلى مرحلةِ الفنّيّةِ والتّغييرِ، والخروج عن الإطار المألوفِ في العمل الرّوائيّ، وهل كلُّ ما كُتبَ حتّى الآن في أدبِنا المَحلّيّ في فلسطين، لا يَرقى لأنْ نُطلقَ عليه عملاً روائيًّا إبداعيًّا، يَحملُ عناصرَ ومكوّناتِ الرّوايةِ الفنّيّةِ الّتي بإمكانِها أن تحكي عن الواقع، بالكثيرِ مِن الدّهشة والتّعبير والمشاعرِ وكذلك الأسلوب؟
اليومَ نرى أنّ هناكَ حركةٌ أدبيّةٌ نشطةٌ، إن كانَ شعرًا أو قصّةً أو رواية، لكن تبقى الجوانبُ الأهمّ، وهي المؤسّساتُ الثّقافيّةُ ودُور النّشر ووسائلُ الإعلام، والسّياسةُ الدّاخليّةُ في دمْجِ حضارتيْن داخلَ ثقافةٍ واحدة، وماذا عن الكاتب نفسِهِ وقضيّة التّوزيع؟ وأين وكيف؟
الرّواية كجانر أدبيٍّ فنّيٍّ تحتاجُ لوقتٍ كبيرٍ، واليومَ وفي زحامِ هذه المعمعةِ بينَ التّطوّرِ والحرّيّةِ، وبينَ التّحدّي الّذي كانَ مِن نصيبِ مَن عاشروا وعاشوا زمنَ النّكبة، وتحدّوْا للظّروفِ الصّعبة، للحفاظِ على اللّغةِ العربيّةِ مِن القمع؟
هل نحنُ اليومَ بحاجةٍ لجسمٍ سياسيٍّ لولادةِ روايةٍ، نطلق عليها "أدب المقاومة" كما "شعر المقاومة"؟ برأيي؛ إنّنا بحاجةٍ لعملٍ روائيٍّ فيه اختراق، ولغةٍ روائيّةٍ تدهشُنا وتنقلُنا مِنَ المكان وتتصاعد، بحيث تُعزّزُ فكرةَ الواقع التّاريخيّ وفنّيّةَ اللّغة، دونَ هضْمِ أحدِ الجانبيْن، فما الّذي يمنعُ روائيًّا مبدعًا خلاّقًا أن يجمعَ بينَ الخطابيْن، حتّى لو كانتِ الرّوايةُ بمضمونِها تحكي تاريخَ فلسطين ومعاناتِهِ؟
وأحيانًا كتوثيقٍ لذاكرةِ شعبِنا، ما الّذي يمنعُ روائيًّا أن يخوضَ هذا الجانر من الفنون ويستمرَّ في الكتابة، وهو لا يمكنُهُ الخروج مِن تلبُّسِ لغةِ الخطابة والأسلوب التّقريريّ في أعمالِهِ الرّوائيّة
لستُ هنا بموقفِ المقارنة ولا بالنّاقدة، لكنّني أتابعُ ما يُنشرُ محلّيًّا وعالميًّا، وأرى كم تفتقرُ الرّوايةُ المحلّيّة لمن يُخرجُها مِن ركودِها ويُحييها مِن جديد، وأنا أؤكّدُ أنّ المبدعَ في أيِّ عملٍ أدبيٍّ كان، يستطيعُ أن يسمُوَ بلغتِهِ الفنّيّةِ، فاللّغةُ ليستْ جمادًا ولا حِكرًا لقاموسٍ ومُعجمٍ معيّن، بل على المبدعِ أن يُواكبَ عمليّةَ الحداثةِ في حياتِنا اليوميّة، اجتماعيًّا ثقافيًّا وسياسيًّا، ليُطوّرَ أساليبَهُ الفنّيّة، وهنا لا أطالبُ الرّوائيَّ في أدبِنا المَحلِّيِّ بالتّخلّي عن إنتاجٍ أدبيٍّ يَحكي تاريخَ أرضِنا، ويُوثّقَ ذاكرةَ شعبِنا، لكن بإمكانِ هذا العمل الرّوائيِّ أن يكونَ مكتمِلاً، إذا استطاعَ الرّوائيُّ أن يُوازنَ بينَ التّاريخ وفنّيّةِ الكتابة، ومِن هذا المنطلق ارتأيتُ تقديمَ بعضِ النّماذج، علّ المتلقّيَ يَصلُهُ ما أعنيه.
مِن الطّبيعيِّ أن أستشهدَ ببعضِ الفقراتِ مِن رواياتٍ محلّيّة، حملتْ طابعَ الخطابِ التّاريخيِّ أو الخطابِ الرّوائيِّ الفنّيِّ وهي قليلة، لكنّني أذكرُ مِن أسماءِ الرّوائيين في أدبِنا المحلّيّ، وسأختارُ مِن بينِها نصوصًا كمقاطعَ مِن روايات:
*إميل حبيبي/ المتشائل/ سرايا بنت الغول/ *د. حنا أبو حنا/ ظلّ الغيمة (سيرة) اعتبرت رواية * د. فؤاد خطيب/ ذاكرة العنقاء/ طاحون الزمن *رجاء بكرية/ عواء ذاكرة/ امرأة الرّسالة/ والصندوقة " قصص" * نبيل عودة/ حازم يعود هذا المساء/ المستحيل/ المرأة على الطرف الآخر *فاطمة ذياب/ رحلة في قطار الماضي/ الخيط والطّزيز *هدية صلالحة/ أجراس الرّحيل *معين حاطوم/ زمهرير الكرملي يكشف أسرار الكون، بجزئين *نجيب سوسان/ صدى الأيام *هيام مصطفى قبلان/ رائحة الزمن العاري * سهيل كيوان/ المفقود رقم 2000/ عصيّ الدمع * هادي زاهر/ السّرّ الدفين ….
وهناكَ أسماءٌ أخرى لكنّني سأكتفي، كي أقتبسَ مقاطعَ مِن روايات، وأختار (ظلّ الغيمة) للد. حنّا أبو حنّا، وهي ربّما سيرةٌ ذاتيٌة أو توثيقيّة، والّتي بسردِها تعتبرُ روايةً، بأسلوبِهِ السّرديِّ والوصفِ إذ يقولُ في عدلة وفارس:
"كانتْ عدلة واقفةً تنشرُ الغسيلَ على الحبل، ويداها ترفّانِ كجناحَي النّحلةِ، والقامة الجمريّة يتراقصُ لهبُها حينَ تنحني تلتقطُ الثّوبَ مِن اللّجَنِ، وتنتصبُ تنشرُهُ على الحبل، وتثبّتُهُ بالملاقطِ لتحضنَهُ النّسماتُ الرّبيعيّة، وعلى شجرةِ الرّمّانِ وتحتها عصافيرُ الدّوريّ تتقافزُ وتزقزقُ، والشّمسُ تسري في الشّرايينِ دفئًا ظامئا".
وفي مكانٍ آخرَ في وصْفٍ: "ذاكرةٌ للعينِ وذاكرةٌ للفم وذاكرةٌ للأنفِ وأخرى للأذن". أمّا عن القبلةِ الأولى في سيرته يقول: "كانتْ مكتنزةَ الجسم، بياضُها كالحليبِ الّذي تعشقُهُ موجةٌ شقراءُ مِن العسل، في صوتِها غنجٌ يحتضنُكَ فترافقُه إلى حيث يشاء، وشَعرُها الخرّوبيُّ أطفالٌ سُمْرٌ يَلهونَ بالرّكضِ على شواطىءِ الجبينِ والخدّيْن، لم يَرَ ذلك قبلَ زلزالِ تلكَ القبلة، حينَ احتضنَتْهُ قبلَ يوميْنِ وقبّلتْهُ على خدّيْهِ لم يَجفلْ عصفورٌ، ولم تتحرّكْ حبّةُ رمل".
مِن هذهِ الصّورِ والمشاهدِ ما يُلغي أحيانًا التّسمياتِ ما بين (السّيرةِ والرّواية)!
وهذا مقطعٌ مِن روايةِ "المتشائل" لأميل حبيبي: "أقبَلَ العسكرُ فبقيتُ في موضعي بلا حراكٍ، سوى أنّي وضعتُ يدي فوق عيني فأغمضتها، حتّى لا أرى النّهايةَ كما رأيتُ البدايةَ، وأسمعُ مِن فوق في منزلي صراخًا أنثويًّا، وصوتَ لطماتٍ وركلٍ وجلبةٍ، وأرى معركةً حاميةً تدور بين "يعاد" والعساكر، وأراها تقاومُ وتصرخُ وتركلُ بقدمِها، وأراهم يتكاثرون عليها ويدفعونَها أمامَهم إلى سيّارةِ التّرحيل".
ويتكرّرُ الموقفُ معَ العمّةِ نزيهة العجوز في "سرايا بنت الغول"، التي تُفتَّشُ وتُعرّى في مطار بن غوريون.
النّصُّ الثّالثُ هو مِن رواية (عواء ذاكرة) للرّوائيّة رجاء بكريّة: "أهو العراء؟ فزَعُ التّساؤلِ يشُطُّ قلبي بصنّارةٍ تطير، تحسّستُ ساقيَ السّليمة، أتمضينَ أنتِ أيضًا؟ أمرّرُ أصابعَ راجفةً فوقَ موتي السّفليّ، تقيسُ مساحةَ النّقصِ الّذي يتّسعُ هناك، يتمزّقُ الشّيءُ الّذي لا أعرفُ شكلَهُ داخلَ قارورتي ببطءٍ يحشرج، وتتكوّرُ عضلاتُ وجهي المسمومةُ كراتٍ تتهيّأ للتّفرقع، تنزلقُ مركبي عن شاطئِها هاربةً لعرضِ البحر، تتابعُ نعيقَ البجع واستغاثاتِ السّنونو، لتتوقّعَ شكلَ حصنِها القشّيِّ بعيدًا عن عينِ الرّقباء، لكنّهم يُحطّمونَ مقدّمتَها، لخرْقِها قوانينَ الحظْرِ المفروض، ويعيدونَها لمرفأ حزنِها القديم، وألمحُها سبّابتَك تشيرُ بمحاذاةِ الزّجاج الشّفّافِ لحاملةِ الطّائراتِ في طريقِها للرّسو في ميناء حيفا، "هل تعرفين ماذا يُسمّونها؟ "أتخابث، "خبّرني يا قاموسي الحربيّ". تهمسُ بحّتُكَ، وعيناك ترحلان عكس إبحارها: "إنّها حاملةُ الطّائرات".
في مكانٍ آخرَ في الرّواية تقول: "سيقتلُني شبقُكَ المجنون.. سيقتلني". تحدّقُ في عل "ستقتلُني حموضةُ تفّاحِكِ يا غجريّة". يجب أن ننتهي/ لن ننتهي/ اِمضِ إلى مجهولِكَ، وإن عُدْتَ برغمي لن تجدني/ نحن لنا/ لستَ مرفئي/ أنتَ مرسايَ/ أكرهُكَ.. أحبّكَ/ أريدكَ / أحبّكَ/ حبيبي أنا/ أمقتُكَ بعددِ شعرِ جسدي/ لا شعرَ لجسدِك – سأذهبُ إليه – لن تذهبي – الرّعبُ الّذي يفترسُ أطفالَهُ أحقُّ بوقتي منك، أنت طالق – لن ترحلي- وجودُنا هباء/ وجودُنا حقيقةٌ وواجبةٌ حقيقة، هل تفهمين؟"
وبما أنّنا نقفُ أمامَ نماذجَ مِن رواياتٍ لم تخرجْ عن موضوعِ الذّاكرةِ الفلسطينيّةِ والتّاريخ للشّعبِ الفلسطينيّ، خاصّة في حدود عام 1948، على المتلقّي أن يعي أنّنا نملكُ القدرةَ ككتّابٍ محلّيّين في التّوازن بينَ الخطابيْن التّاريخيِّ والأدبيّ، إن كنّا نملكُ حقًّا الفطرةَ الإبداعيّة، إذ إنّه لا زمانَ ولا مكانَ للإبداع، والتّجربةُ لا تفرضُ قانونَها على معاقرةِ المبدعِ لعملٍ فنّيٍّ مدهشٍ حقيقيٍّ بينَ الواقع والمتخيَّل، وخاصّةً في الكتابةِ الرّوائيّةِ، وأتركُ سؤالاً لن يكونَ خاتمةَ الأسئلة: ما هو دوْرُ النّقد العربيِّ في الرّوايةِ المحلّيّة داخل حدود ال48؟ وهل يهتمُّ الإعلامُ العربيُّ بإظهارِ مبدعينَ غَيّبتْ أسماءَهم وسائلُ الإعلام؟