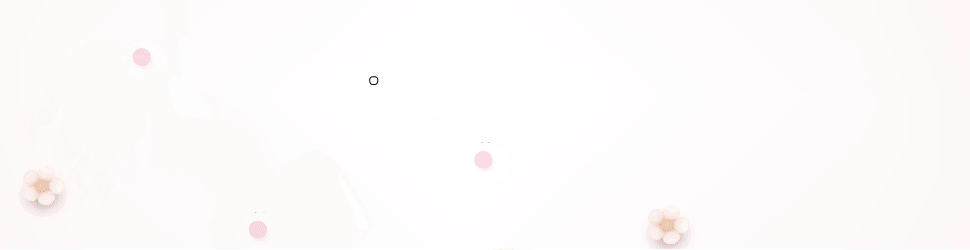كانت الحرب التي طالت أيّامُها أكثرَ من اللازم تشْرف على الانتهاء. ساعات العصر ذروةُ اليوم، والليل سيأتي عندما تلوِّن المستطيلاتُ البرتقاليّة حائطَ الشقّة الشرقيّ. كان الليل صديقهم دومًا، لكنه الآن منقذَهم الموعود. يُنشدون أغانيَ جديدة، يؤلّفونها بإلهامٍ جماعيّ وضحكاتٍ مبهورة من سجع الجمل المتلاقية حول معنى اللحن والحالة. كانوا صادقين؛ هو نفسُه يكن ممثلاً في تلك اللحظة.
عندما تصْرخ صفّارةُ الإنذار، يضعون كلَّ الأغاني على الكنبة، ويرمون نظراتهم المذعورة والمغامرة تحت الطاولة الخشبيّة الطويلة التي وضعوا عليها كلَّ ما يلهيهم ويصلهم بالعالم الخارجيّ: سجائرَهم، منفضتهم، محفظاتهم، هواتفَهم النقّالة، روايةً لم يكْمل قراءتها بعدُ، كرّاسَ نوتةٍ لتعليم الجيتار، جهازَ التحكّم بالتلفزيون الخائب غير المربوط بأيّ صحنٍ فضائيّ، فتاتَ دخانٍ مبعثّر، مكعّبَ شوكلاطة صغيرًا جدّاً يختبئ وراء ورقة بيضاء. عندما تصْرخ صفّارةُ الإنذار يهربون نحو مطلع الدرج، وتتحوّل آذانُهم إلى رادارت، ورجفاتُهم المكبوتة إلى صلواتٍ صريحة.
لم تصْرخ الصفّارة منذ ساعتين. كانت ترجمة كلمات أغنية "وحيد" قد وصلتْ إلى صيغةٍ أفرحتهم جميعًا؛ فقد ترجموها من العبريّة إلى العربيّة الفصحى، فانتفختْ معانيها، وأصبحتْ أكثرَ جدّيّة وحزنًا. قرّروا أن يغنوها معًا: "وحيد ذاهب، بلا صلاة، وحيد بلا مستقبل، بلا أمل، بلا حلم." ردّدوا منفعلين، بأصواتهم المتناسقة رغم بشاعتها النسبيّة: "وحيد."
وحده صوته كان جميلاً، لكنه ضاع في فوضى الطرب. لم يهتمّ لعدم اكتراثهم بموهبته. ترّقبه لصرخة الصفّارة، وخوفه من سوء الحظّ، يمنعانه من تناسي الخطر المحْدق به وبضيوفه اللاجئين إلى شقّته المستأجرة. كان استنتاج صديقه رضوان أنّ الأمر متعلّق فقط بكميّة البنزين الذي يضعه محاربو حزب الله في الصاروخ مقلقًا حقّاً، وقد سقطتْ صواريخُ كثيرة على الميناء البعيد كيلومتراتٍ قليلةً عن شقّته، وسقطتْ في وادي النسناس، وعلى بريد حيّ الهدار القريب. "بدنا شويّة حظّ،" قال صديقه. "بدنا بنزين أقلّ، أو أكثر،" أجاب.
عندما عاد من المطبخ حاملاً زجاجة ماء، شاهد حركة غريبة في بيت جيرانه، وسمع جلبةً من مطبخهم وأسئلةً قصيرةً بالروسيّة. اقترب نحو الشبّاك ومدّ رقبته، لتلتقط عيناه مشهدًا أفضل. كانت جارته تمشي عارية في بيتها. وكان قد شاهد زوجَها قبل أيّام ينزل الدرج مستعجلاً، وهو يحمل حقائبَ ويصرخ بحزمٍ على ابنته وابنه. سمعه يقول "بئر السبع"؛ ويبدو أنها بقيتْ هنا. قسّمتْ مصاريعُ شبّاكه جسمَها الأربعينيّ المتماسك، وظهر من بينها جسمٌ آخر، واختارا تلك الزاوية ليتداعبا.
ظنّ أنها لا تراه. لكنها عندما رفعتْ عينيها الشبقتين عن شعر عشيقها، رأت جارَها الشابّ يحدّق إليهما. ابتسمتْ له وجلستْ على الطاولة، لتصعّد المعركة غيرَ آبهة لوجوده، أو ربما لتصعّب عليه صمودَه في الحرب، ولتعاقبه على تمنّعه من قبل. كأنها تقول له: "أنا حرّة، سمّيها شو ما بدّك تسمّيها، عيب أو غلطة كبيرة أو حتى جريمة، مش فارقة معي. أنا مبسوطة بهاي الحرب مليون مرة أكتر من أيّامي العاديّة التعيسة. التغيير منيح. اتعلّم كيف الناس المتحضّرة بتعمل سكس."
كان رضوان يفكّ أزرار بنطلونه الجينز قاصدًا حمّامَ شقّة صديقه، الذي يمسك زجاجة الماء بيديه الاثنتين ويحدّق من الشباك.
ـ تعال..تعال، وشْوَش.
ـ ولكْ شو هاد؟ الجماعة فرطوها عالآخر.
ـ جوزها ببير السبع.
ـ لاه!
ـ ليش مستغرب، صديقي؟ بطّل في قوانين من زمان.
ـ أنادي الشباب؟ حرام، مقاطيع، على الأقل يشوفوا!
أغلق المصاريع بسرعة، فاختفى صوتُ صفّارة نشوة الجارة وعشيقها. أما رضوان فدخل متحسّرًا إلى الحمّام القريب.
عاد إليهم… أو هم الذين عادوا إليه، في لحظةٍ مشتركة، من دون أيّ تنسيق. كان قد اعتاد الخوفَ لوحده، كما اعتاد التحمّلَ والاستمرار. فاجأوه، ولم يزعجه حضورُهم؛ الحرب هي التي أزعجته بمفاجأتها. كان يريد صيفًا مختلفًا وضيوفًا آخرين. يريد العطلة كما كانت في أوّل شبابه: بحرًا ونومًا ومغامراتٍ غير محسوبة. كان يأمل أن ينشّف الحرُّ بحرَه المضطربَ منذ كانون، حين قرّر أن يقول لها: "لا، لم أعد أريدك، ومن بعدي الطوفان."
هذه الحرب لا تريد أن تنتهي، وهو ليس مقاتلاً، بل محتجٌّ عليها في أحسن الأحوال.
عادوا إليه من فتراتٍ انتهت، وهذا ما زاد من خوفه؛ كأنهم جمّعوا له حياته في علبة سجائر ليدخّنَ آخرَ سيجارة منها. لا يريد لسوء حظّه أن يأخذهم معه، أو يبقيه حيّاً من بعدهم، بل أراد أن يبقى الجميعُ على قيد الحياة. لم ينهِ صداقته بهم مثلما لم يستطع أن يقْلع عن التدخين. لا يعرف كيف ينهي العلاقات. متمرّس في البدايات، أستاذ في أول رحلة إلى حديثٍ طويلٍ ومشهدٍ مكثّف التفاصيل، لكنه لا يعرف طريقَ العودة من أيّ مكان، ولا يعترف بدوره في الضياع، فيختفي بين أشجار الليل خلف الطرق الترابيّة الموحلة، ويعتذر. إلا أنه يحضنهم عند لقائهم مصادفةً، كأسدٍ اعتزل الغابة، ويعاتبهم لغيابهم، ويعِد بمكالمةٍ وقعدةٍ مثل أيّام زمان، ولا يفي بشيء.
صفّارة الإنذار لم تصرخْ منذ ساعتين؛ وهذا في حدّ ذاته إنذار.
لم يتعرّف ضيوفُه بعضُهم ببعض من قبل. وهو يدرك بعمقٍ شدّة اختلاف شخصيّاتهم، والحالةَ الدراميّة التي تجمعهم؛ فهو ممثّل بارع لأنه يفقه بعلم الشخصيّات، ويشعر بالحالات، ويخفي ذاته الحقيقيّة أو يفجّر جزءًا مخبأً منها بحجّة التمثيل. لم يبدأ مشواره بعد، لا زال قابعًا في عتمة المشهد الفنيّ. بيْد أنّ الضوء سيسلَّط عليه حتمًا. يعرف هذا، ويتخيّله دائمًا. يرى الجمهور واقفًا على رجليه يصفّق بحماس، ويرى صورَه على لوحات الإعلانات بجانب سنابل الجوائز.
"على الممثّل أن يفهم الشخصيّات الأخرى بعد أن يفهم شخصيّته هو، فالحياة ليست مونودراما،" يجيب مقدّمة البرامج عندما يستحضرها أحيانًا على الكنبة الوحيدة إلى جانبه، ويحكي لها عن طفولته وولائه للموهبة، وعن إصراره على المضيّ خلف حلمه في أحلك ليالي اليأس والعزلة، ويضحك بأناقةٍ خجلاً من مديحها.
لا يريد أن يرى الآن إلاّ أصدقاءه. لا يريد أن يراها، ولا أن يرى أهله. هو تركها، وهم تركوه. وهي تذيع في كلّ مقاهي المدينة أنها هي التي تركته لأسبابٍ كثيرة، وتسحقه بموهبتها القصصيّة.
يرى عمّارًا يداعب يدَ الكنبة بأطراف أصابعه، بينما يحاول رضوان أن يجد الأكوردات الصحيحة لأغنيةٍ أخرى "دق عَ بواب الجنّة." وأما إبراهيم فقد كان منهمكًا بترجمة كلماتها. قال له عمّار: "الليلة كان لازم يكون عرسك!" هزّ رأسه موافقًا، بابتسامةٍ غير آبهة. "متذكّر، صدّقني،" أجابه.
يمسك رضوان بإيقاع اللحن وبالأوتار الصحيحة، وينقّل أصابعَه بينها. يبدأ إبراهيم الغناءَ بصوتٍ منخفضٍ ليجرّب إنْ كانت الترجمة ستجلس على مقاعد اللحن. "يمّا خدي عنّي الهويّة، راح تاريخي من زمان، في عتمة جاي..عتمة قوية، حاسس إني عَ بواب الجنّة." وأنشدوا معًا: "دق دق دق عَ بواب الجنّة".
صفّارة إنذار تصرخ فجأة، تحتلّ الصوتَ في حيفا. يقف ويصيح بهم: "على مطلع الدرج..يلا..على مطلع الدرج." ويركضون. ملأوا عتبة البيت في الطابق الأول قرب المدخل، بعيدًا عن مرمى الزجاج القابل للانكسار. وقفوا مجْبرين كطلاّب مدرسة في طابور صباح. وبعد أن توقّفت الصفّارة بنهايتها المرعبة، شغّلوا الرادار ورفعوا آذانَهم حتى السماء. تماسكوا قدر المستطاع.
صفير طويل وسريع، وانفجار قريب هزّ كلَّ الحيّ، وارتجفتْ منه العمارة التي تكسّر زجاجُ باب مدخلها. نظروا بعضهم إلى بعض مشدوهين، وتحرّكوا متوتّرين حول أنفسهم. سحابةُ دخانٍ أسود كثيف تغطّي الحيّ. يخرجون من العمارة بخطواتٍ سريعة ليفهموا ماذا يجري من حولهم. يركضون على الدرج الحجريّ الموصِل إلى شارع "هس" ويلهثون. عند نهاية الشارع حريقٌ هائلٌ لكلّ سيّارات الحيّ، تشتعل كلُّ واحدة بلا تمييزٍ على أساس اللون والأصل والعمر والحالة الاقتصاديّة.
دوريّات تولول في شوارع المدنية، تأتي إلى الشارع القريب من كل حدب وصوب. لم تطلبْ منهم الشرطة أن يبتعدوا، ولم تأبهْ لوجودهم. صفّارة إنذار جديدة. يختبئون في مدخل عمارةٍ قريبةٍ، حيث تجمّع مَن بقي من عجائز الحي وفقرائه.
عندما نزلوا من جديد على الدرج الموصل إلى شارع "هلل" كانت وجوهُهم صفراء، ولم تعد أرجلهم تجيد المشيَ الثابت. تركوه عند الزجاج المكسّر في مدخل بيته، ومشى كلٌّ في طريقه عند أول مفترق. عاد عمّار إلى تصميماته التجاريّة والاحتجاجيّة، ورضوان إلى صفقاته المربحة نظريّاً، أما إبراهيم فعاد إلى زوجته الجديدة التي شغلتْه عن عاداته الأولى.
فتح مصاريعَ شبّاك شقّته الداخليّ المطلّ على بيت جارته. كانت شبابيكُه مغلقة تمامًا، والعتمة تؤكّد موقف الهدوء. لقد ذهبت الجارة، أو أنها سافرتْ أصلاً إلى بئر السبع مع زوجها.
الشمس الغائبة ترسم مستطيلاتٍ برتقاليّة على حائط الشقّة الشرقيّ، ونسيمٌ منعشٌ ينسحب من المنافذ الصغيرة ليخفّف عنه. كان الليل صديقه دومًا، لكنه الآن منقذُه الموعودُ الصادق. ينشد أغانيَ جديدةُ يؤلّفها بإلهامٍ ينثر الجمل المتلاقية حول معنى اللحن والحالة. كان صادقًا. كان يمثّل ذاتَه في تلك اللحظة.
كان يريد أن يتحدّث مع أحد؛ فمن المفروض هذه الليلةَ أن يكون عريسًا، يدور من حوله الناسُ ويضحكون له ويذكرون اسمَه طيلة الوقت. أراد أن يشرح نفسه، ولو لواحدٍ من أصدقائه، كي لا تموت معه الحقيقةُ، أو يجرحهَا زجاجٌ محطّمٌ من صدمة كاتيوشا ذكيّة، وكي لا تعيش الكذبةُ وأنصافُ الإشاعات معه إلى الأبد.
أراد أن يشرح لماذا تركها، أو تركته. أراد أن يفسّر نفسَه مرّةً واحدة فقط، وأن يشْركَ أحدًا بقناعته أنّ على الإنسان أن يقول "لا" أحيانًا وأن لا يخافَ من تعقيدات الدنيا (لا خجل عند المفاوضة على المصير)، وأنْ يقول دون أنْ يفسّر: "أنا حر،" وأن يوصل لها مع أحدهم: "حتى لو تركتيني، خلص، عن جدّ اتركيني، وخلّيني ساكت." ولن يقول لأحد إنه لن يشطر قلبَه حزنًا إنْ كانت كميّة البنزين في الصاروخ الصغير تكفي للسقوط في حضنها. لا داعي لهذه التصريحات.
يدندن على الجيتارة ألحانًا معروفة، وخلفه أضواءُ مصانع تكرير البترول ورافعات الميناء وخليج يصل إلى عكا ونهاية جبل تخفي وراءها لبنانَ. يفكّر أنه كان من الممكن أن يكون لبنانيّاً لو كان سايْكس أكثر تسامحًا مع بيكو قبل 90 سنة، وأهل قريته الجليلية كانوا سينزحون الآن نحو الشمال كما نزحتْ عائلته إلى بيت لحم جنوبًا. وكان من الممكن أن يمثّل في مسلسلٍ سوريّ دراميّ لتشاهده الشعوبُ العربيّةُ في رمضان بعد صلاة التراويح، أو في فيلم مصريّ يصوّر من جديد رواية الوسادة الخالية لكي تعلّق المراهقاتُ صورَه على خلفيّة شاشات الحواسيب.
ينظر إلى الورقة البيضاء التي كتب عليها ترجمة الأغنية الأولى. يقلّب حرفين ويغيّر كلمتين، فتصبح أغنيةً أخرى: "وحيد ذاهب مع الحياة، وحيد إلى مستقبل إلى عمل إلى حلم."
يغنّي وحيدًا في ليلة حربٍ مملّة، بدلاً من أن يرقص في عرسه. لا بأس؛ فلديه حظّ، إذ كان في الصاروخ بنزينٌ أكثر.