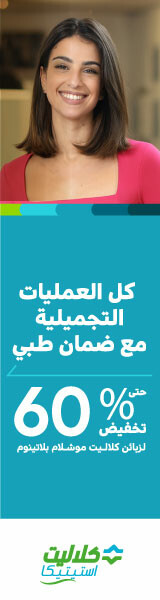د كميل ساري (مدير قسم الرقابة، الأبحاث وصيانة الآثار)
تأسّست مدينة الرملة خلال القرن الثّامن ميلاديّ (712–715م.)، من قبل سليمان بن عبد الملك، وكانت آنذاك عاصمة جند فلسطين الّذي شمل ضمن حدوده آنذاك لواء السّامرة ويهودا. ويجدر بالذّكر أنّه في فترات زمنيّة معيّنة، كانت أهميّة المدينة تضاهي أهميّة مدينة القدس! توسّعت المدينة ابّان الفترات العباسيّة والفاطميّة، وأصبحت من أهمّ المراكز الاقتصاديّة في المنطقة، وذلك لسبب موقعها على الطريق الرئيسيّ الواصل بين القاهرة، دمشق، يافا والقدس.
الجامع الأبيض
إنّ الحفريات الأثريّة الأولى في مدينة الرملة، أجراها الباحث يعقوڤ كاپلن، في الجامع الأبيض عام 1949. وقد حدّد الباحث بأنّ الهدف من وراء التّنقيبات، تحديد مجمع المباني التّابع إلى الجامع من الفترة الأمويّة. وقد كشفت الحفريات على أنّ المبنى الّذي يعود للفترة الأمويّة كان مستطيل الشّكل (طول أضلاعه: 84X93 مترًا) يرتكز على الأعمدة. شمل مجمع المسجد آنذاك: مبنى الجامع، رواقًا تزيّنهما صفّان من الأعمدة في جانبي السّاحة الأماميّة (من الجهتين: الشّرقية والغربيّة)، المأذنة، وثلاث مجمعات تحت الأرض لتخزين المياه.
توسّط قاعة الجامع صفّ من الأعمدة الّتي دعمت سقف الجامع، بينما نلاحط أنّ الحائط الشّمالي احتوى 13 مدخلًا. ومن الآثار المتبقّية، نلاحظ بأنّ السّقف كان مُدعّمًا بالأقواس المتصالبة. ووفقًا لما يعتقده الباحثون، فإنّ هذا السّقف يعود تاريخه إلى الفترة الأيوبيّة (القرن العاشر ميلاديّ).
فوق المدخل باتّجاه البرج الأبيض (الّذي يتواجد حاليًا في ساحة الجامع)، توجد كتابة باللّغة العربيّة، تشير إلى أنّ البرج بُني عام 1318 م. من قبل السّلطان ناصر محمّد بن قالون. وقد وصف المؤرّخ مجير الدّين (1456–1522 م.) البرج كواحد من عجائب الدّنيا، آنذاك.
أمّا مجمّعات المياه الثّلاث، المتواجدة تحت سطح الأرض، فهي عبارة عن أحواض كبيرة مسقوفة بالأقواس، وقد وصلت المياه إلى المجمّعات الثّلاث من مياه الأمطار، وبواسطة قناة جلبت المياه من الينابع خارج مدينة الرّملة، والمتواجدة على مقربة من تلّ الجزر اليوم.
الحفريات الأثريّة
يمكننا الإشارة إلى أنّ الحفريات الأثرية بالموقع، ساهمت في توضيح مراحل بناء الجامع، والّتي يمكننا تقسيمها إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: المبنى المستطيل الّذي كان فيه يتواجد الحائط المتّجه إلى «القبلة» أطول بأضعاف المرّات من الجدران الجانبيّة. هذا النمط أتاح لعدد كبير من المصلّين الوقوف قريبًا من المشكة الّتي تشير إلى القبلة. وقد شاع بناء المساجد بهذا الشّكل خلال الفترة الأمويّة.
المرحلة الثّانية: هذه المرحلة جاءت عام 1190 ابّان فترة صلاح الدّين، حينها تمّ ترميم الجامع بعد أن كانت قد تضرّرت أجزاء منه خلال الهزّة الأرضيّة الّتي ضربت المكان عام 1033 م. غالبيّة أجزاء الجامع الّتي نراها اليوم تعود لتلك الفترة.
المرحلة الثّالثة: تشمل بناء البرج الأبيض خلال فترة المماليك.
إنّ الحفريات الأثريّة الّتي أُجريت حتّى الآن لم تجب على العديد من الأسئلة الّتي لا تزال مطروحة للنّقاش، وأهمها: أين كانت المأذنة من الفترة الأمويّة؟ كما أسلفنا الذكر، فإنّ البرج الأبيض بُني عام 1318 م. من قبل السّلطان ناصر محمّد بن قالون. وقد ذكر المقدسيّ في كتاباته أنّ للجامع من الفترة الأمويّة كانت مأذنة، بناها هشام بن عبد الملك، لم نعثر على بقاياها خلال الحفريّات الأثريّة.. فأين كان مكانها بالتّحديد؟
من الصّعب الإجابة على هذا السّؤال، فقد تضرّر الجامع بالماضي جرّاء الهزّات الأرضيّة الّتي أدّت إلى الإضرار بالمأذنة. من المحتمل أنّ البرج الأبيض الّذي نراه حاليّـًا، لم يُبنَ مكان المأذنة الأصليّة والّتي يرجّح الباحثون أنّها كانت مُلاصقة تمامًا للحائط الشّماليّ من الجامع، كما كان الحال عليه خلال الفترة العبّاسيّة، أيضًا، بعد ترميم الجامع.
كلام الصور
أرضيّة فسيفساء من الفترة الأسلاميّة عثر عليها إلى الجنوب من الجامع
الجامع، كما هو اليوم
البرج الأبيض، كما هو اليوم
[foldergallery folder="wp-content/uploads/articles/142502560020142107012534"]