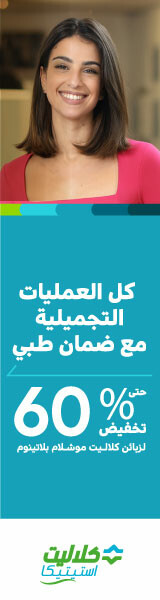المسرح الفلسطينيّ
إنّ أوّل مسرحيّة عربيّة فلسطينيّة ظهرت في القدس نحو عام 1910، حيث قدّم المنتدى الأدبيّ برئاسة المرحوم جميل الحسيني مسرحيّة «صلاح الدّين»، تحت رعاية الملك فيصل. ثمّ عرض هذا المنتدى روايات أخرى، مثل: «السموأل»، «طارق بن زياد»، «هاملت». وعهد بأداء الأدوار النسائيّة في حينه إلى شبّان صغار السّن.. ثمّ عرضت مسرحيّات على مدار سنوات تالية في مدرسة المطران بالقدس، ومن أهمّها مسرحيّة «لصوص الغاب» لنيتشه، عام 1916.
وكان دور هام قام به الأرشمندريت استفان سالم، من الناصرة وعمل في تيراسنطة بالقدس، الّذي وضع عددًا من المسرحيّات، مثل: «سجناء الحريّة»، «غرام ميّت»، «صديق حتّى الموت»، «الموسيقى خير علاج»، «دقّت السّاعة يا فلسطين»، وغيرها. وكتب عدد آخر من الأدباء في فلسطين مسرحيّات متنوّعة، مثل: أسماء طوبي من عكا، وجميل البحري من حيفا. وعادت الحركة المسرحيّة إلى القدس، ليقيم صليبا الجوزي مسرحًا اجتماعيًا، حيث قدّم مسرحيّات وضعها الجوزي في عام 1927 وما بعده.
ولكن نظرًا لعدم الاستقرار السياسيّ واندلاع الحربين الأولى والثّانية، لم يكتب النّجاح لهذه الفرق لكي تنمو وتترعرع، بل انحصر الاهتمام بضمان لقمة العيش.
ومن جهة ثانية فإنّ الإرساليّات التّبشيريّة المسيحيّة الّتي قدمت إلى فلسطين قبل الانتداب البريطانيّ، وبعده سعت إلى فتح المدارس الأهليّة والتّبشيريّة والرهبانيّات، في عدد من المدن والقرى الفلسطينيّة، مثل: القدس والرّملة ويافا وعكا والنّاصرة وغيرها. وكانت هذه الإرساليّات من إنچلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا وألمانيا. وساهمت هذه المدارس بتقديم العروض والمسرحيّات الاجتماعيّة والدينيّة في المناسبات المختلفة. ولعلّ هذا ما يبرز الدّور الدّيني في تأسيس الحركة المسرحيّة في العالم؛ لأنّ المسرح كان ينشأ في الأوساط الدينيّة منذ عهد الفراعنة وبعده اليونان ويليه الرّومان، ومن ثمّ نشؤه من جديد في القرون الوسطى بداخل الكنيسة، كما يبلغنا التّاريخ المسرحيّ. وإنّ المسرح الّذي نعرفه ونشهده اليوم هو استمرار وتطوّر للمسرح الدّيني منذ القرون الوسطى.
وهنا في فلسطين كان لهذه الرهبانيّات والمدارس التّبشيريّة والكنائس الدور الأساسي في إنشاء ورعاية الحركة المسرحيّة الّتي تراوَح صعودها وهبوطها مع صعود وهبوط نفوذ هذه المدارس وتأثيرها. لأنّ المدارس تعتبر إطارًا جيّدًا لحضور المسرحيّات، كما سأورد في ما بعد.
وبالنّظر إلى الأعمال المسرحيّة في المدارس التّبشيريّة نلاحظ أنّها لم تكن تحرص على مداومة العروض الفنيّة أو تنميتها أو صقل مواهب الفنّانين، بل كان العمل ارتجالًا وهوايةً يمكن ممارستها إلى حدّ معيّن لا أكثر، بحيث ينحصر العمل الفنّي على الإطار المدرسيّ فقط، وبانتهاء المرحلة المدرسيّة ينتهي العمل الفنّي.
ويورد كتاب «دراسات في المسرح والسّينما عند العرب» ليعقوب لنداو أنّ عددًا من الفرق المسرحيّة المصريّة كانت تعرض مسرحيّاتها أثناء مرورها ذهابًا وإيابًا بفلسطين؛ وكان لهذا أثر كبير في تنمية وتعزيز وبثّ الرّوح الفنيّة والمسرحيّة في نفوس الجمهور المتعطّش لمثل هذه الأعمال، ومن الفرق المصريّة الّتي عُرضت في فلسطين بين السنوات 1925-1932 فرقة «جورج أبيض» الّتي قدّمت مسرحيّات «لويس الحادي عشر» و«أوديب» و«الشيخ متلوف» الّتي ترجمها عثمان جلال عن «طرطوف» لموليير.
وكذلك فرقة «رمسيس» ليوسف وهبي، الّتي مرّت بفلسطين عام 1933 وقدّمت مسرحيّات متنوّعة، مثل: «أولاد الذّوات» و«راسبوتين» و«سرّ الاعتراف». وكان يظهر مع يوسف وهبي في مسرحيّاته الممثّلون حسين رياض وروز اليوسف وزينب صدقي وفاطمة رشدي وأمينة رزق وعزيز عيد وغيرهم. كما عرضت فرقة نجيب الرّيحانيّ مسرحيّاتها في فلسطين بمشاركة أمين صدقي وبديع خيري وغيرهما.
إضافةً إلى فرقة علي الكسّار الّتي قدّمت عددًا من المسرحيّات الهزليّة، خاصّةً في عكّا. وامتدّ هذا النّشاط حتّى عام 1946؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الفرق المصريّة كانت تستعين بشبّان محليّين في فلسطين لتقديم الأدوار الثّانويّة أو المشاركة في العروض المسرحيّة من ترتيبات وترويج أو تبديل أحد الممثّلين الثّانويين إذا ما أصابته وعكة صحيّة.
ونلاحظ أنّ ظهور الفرق المصريّة في فلسطين لم يساهم بإنشاء فرقة مسرحيّة فلسطينيّة مستقلة، كما لم تتهيّأ الظروف الملائمة لإنشاء مثل هذه الفرقة، وذلك لأسباب عديدة لا مجال لطرحها في هذا السّياق، واعتمد الجمهور لإشباع رغباته الفنيّة وتلبية مطالبه المسرحيّة على عروض الفرق المصريّة الّتي تقدّم له من الكوميديّات والتراجيديّات والاجتماعيّات وغيرها ما يفي بالغرض الفنّي. حتّى أنّ كبار الفنّانين، كعبد الوهاب وأم كلثوم وفريد الأطرش وغيرهم، قدّموا عروضًا فنيّة أيضًا في صالات العرض ودور السّينما الفلسطينيّة.
وبعد حرب 1948 انقطع النّشاط الفنّي حتّى مطلع سنوات السّتين، ولكن جرى عرض لبعض الأعمال المسرحيّة في النّاصرة وقرية الرّامة وحيفا في نطاق عدد من النّوادي الاجتماعيّة وحركات الشّبيبة، وأبرزها النّادي الأنطونيّ وحركة العمل الكاثوليكيّ في النّاصرة. وقدّم هذا النّادي أعمالًا في النّاصرة وحيفا ويافا والقدس، من بينها مسرحيّة: «الآباء والبنون» لميخائيل نعيمة.
ولكن وقوع البلاد تحت الحكم العسكريّ جعل المسرحيّات والنّشاط الأدبيّ والفنيّ عمومًا تحت المراقبة والحصار، إذ لم يسمح الحاكم العسكريّ بأيّ نشاط من شأنه أن يتطرّق إلى واقع الحياة أو الاحتجاج أو الانتقاد، فيحظر هذا النّشاط بصورة تعسفيّة، ولا يتورّع عن سجن الفنّان والأديب أو فرض الإقامة الجبريّة بالأقل.
واستمر النشاط المسرحيّ في المدارس بصورة متقطّعة، بحيث كان يظهر عمل هنا وعمل هناك، وفي المناسبات والأعياد فقط. وكان يشرف على إعداد وإخراج المسرحيّات معلّمون من المدرسة نفسها، وخاصّة معلّمو اللّغة العربيّة لأنّ معظم النّصوص كانت مقتبسة عن قصص وروايات أدبيّة أو تاريخيّة أو شعريّة أو ممّا تبقّى من النّصوص المسرحيّة القديمة الّتي عرضتها الفرق المصريّة أثناء مرورها في فلسطين. وظهرت مثل هذه المحاولات المسرحيّة في عدد من قرى الجليل مثل: معليا، الرّامة، كفرياسيف، عبلين، عيلبون، كفركنّا وغيرها. هذا عدا عن النّشاط الّذي ظهر في المدارس الأهليّة، في كلّ من النّاصرة وحيفا.
المسرح في النّاصرة
تأسّست في النّاصرة عام 1962 فرقة مسرح في نادي الـ«هستدروت»، التّابع لنقابة العمّال العامّة، وذلك لأنّ مدير هذا النّادي كان من الأدباء الفلسطينيّين، وهو الكاتب إبراهيم شباط. وقدّمت هذه الفرقة عددًا من المسرحيّات، مثل: «الصّفقة» لتوفيق الحكيم، و«محاكمة جان دارك»، و«شمعدانات الأسقف»، و«البؤساء»؛ ثمّ توقّف نشاط هذه الفرقة في حَزيران 1966.
واستمرّ النشاط في النّاصرة، حيث تأسّس «المسرح الحديث» عام 1965، وقدّم أعمالاً مسرحيّة بلغ عددها 12 مسرحيّة بين التّأليف المحلّيّ والعربيّ والأجنبيّ، مثل: «السّر الرّهيب»، «الأيدي النّاعمة»، «مجنون ليلى»، «الورطة»، «البخيل»، «مريض الوهم»، «المترافعون». وكان العمل الفنّي يقام بإرشاد المخرج أنطوان صالح (ابن النّاصرة)، الّذي يعتبر أوّل مَن درس المسرح من النّاصرة، وقد سافر إلى فرنسا لدراسة الإخراج، ثمّ عاد ليمارسه مع المسرح الحديث، وهذا شجّع هواة آخرين ليزيدوا من اهتمامهم بالمسرح ودراسته والاقتداء بالمخرج، مثل المخرج ڤكتور قمر وصبحي داموني وغيرهما.
وبقي هذا المسرح حتّى سنوات السّبعين الأولى، ثمّ تفرّق أعضاؤه إلى مجالات أخرى. بقي المخرج أنطوان صالح في المسرح الحديث مدّة سنتين فقط، ولكنّه انفصل عنه ليؤسّس «المسرح الشّعبيّ» في الناصرة عام 1967، ولكن هذا المسرح تمكّن من تقديم مسرحيّتين فقط، وهما: «الأب» لستريندبرچ، و«خادم السيّدين» لچولدوني. واستقطب هذا المسرح الممثّلين يوسف فرح وأديب جهشان من حيفا، وهما أوّل عربيّين يدرسان التّمثيل في المعهد العالي للتّمثيل في «رمات غان». إلّا أنّ كلّاً من يوسف فرح وأنطوان صالح وڤكتور قمر انتقلوا للعمل في التّلفزيون عندما تأسّس في القدس، وانحلّ هذا المسرح.
«المسرح الناهض»، و«الكرمة» في حيفا
تأسّس «المسرح النّاهض» في حيفا عام 1967، لكنّه استقلّ في 1971، وتحوّل إلى مسرح محترف في نطاق «بيت الكرمة»، ثمّ انسحب من هناك، لأنّ وزارة المعارف والثّقافة قرّرت دعمه، وخشي العاملون فيه بأن يُفسّر ذلك بأنّه سيتبع للوزارة، وبقي هذا المسرح يعمل حتّى عام 1977، إلى أن توقّف بسبب الصّعوبات الماليّة الّتي واجهها، ولكنّه تمكّن في هذه المرحلة من استيعاب المهتمّين والدّارسين للمسرح، وقدّم مسرحيّات، مثل: «الزّوبعة»، «البيت القديم»، «حلّاق بغداد»، «رومولس العظيم»، «وبعدين»، «مهما صار»، وغيرها.
واعتبر هذا المسرح بدايةً للحركة المسرحيّة الّتي لم تنقطع في الجليل حتّى اليوم، بالرّغم من تبدّل الأعضاء أو الإدارة، وساهم في العمل الفنّي في هذا المسرح كلّ من: أديب جهشان ومكرم خوري وسمير البيم ووديع منصور وحسن شحادة وحبيب وفريال خشيبون ويوسف عبد النور ومروان عوكل ورفول بولس ورضا عزام وسهيل حداد وغيرهم. وظهر بعد «النّاهض» «المسرح الحرّ» في حيفا، وقدّم هذا المسرح عملاً واحدًا هو مسرحيّة «زغرودة الأرض» للكاتب سهيل أبو نوّارة وأخرجها أنطوان صالح، وقام بالدور الرئيسيّ فيها يوسف فرح.
وظهرت في حيفا فرق مسرحيّة أخرى في نطاق مدرسيّ، كما حدث في مدرسة «الراهبات الكرمليات» ومدرسة «راهبات النّاصرة»، ولكن المسرح الّذي لا يزال يعمل باستمرار منذ «النّاهض» هو مسرح «الكرمة» التّابع لـ«بيت الكرمة»، وأصبح يتلقّى مساعدات ماليّة من وزارة الثّقافة، ويقدّم عروضه في المدارس.
المسارح المدرسيّة
قدّمت كلّ المسارح الّتي ظهرت أعمالها المسرحيّة أمام طلّاب المدارس، فيقوم مسوّقو المسرحيّات بعرض برامجهم على مديري المدارس، وهؤلاء ينتقون بدورهم ما يحلو لهم للعرض على الطّلّاب. وأصبحت هذه ظاهرة ذات وجهين: أوّلاً، لأنّ الإطار المدرسيّ مُلزم للطّلّاب لمشاهدة مسرحيّات، حتّى وإن لم تكن على أفضل مستوى فنّيّ، ولكنّ المسارح حرصت على تقديم مواضيع تربويّة، كمكافحة المخدّرات والحذر على الطّرق، ومكافحة العنف وغيرها، ولكنّها لم تحرص على الإخراج اللّائق، وأصبح المجال مُشاعًا لمن يشاء بتقديم ما يرغب.
ثانيًا، توخّى مديرو المدارس تربية نشئ جديد على محبّة المسرح وتعريفه على أهميّته؛ ولكنّهم تعاملوا مع المسارح على أساس تجاريّ لا فنّيّ، فأيّ مسرحيّة تكلّف تكلفةً باهظةً لا يقبلونها، ولعلّ المسرحيّات الزهيدة التّكاليف تكون زهيدةً فنيّـًا أيضًا. وكثير من هذه المسارح لم يُكتب له النّجاح، فانسحب من المجال.
مسرح «الميدان»
تأسّس مسرح «الميدان» كجمعيّة مستقلّة عام 1995 في حيفا، واهتمت البلدية بتقديم الدعم اللازم له إلى جانب وزارة الثّقافة ليتمكّن من الاستقلاليّة والعمل بشكل حر تمامًا. واتّخذ المسرح مدينة حيفا مقرًا له ودأب على أن يصبح المسرح العربي القطري في البلاد، بحيث يقدم مسرحيّات تلبّي أذواق كافّة فئات الجمهور، ويحرص على استيعاب خريجي المعاهد المسرحية العليا في صفوفه، وتأهيل تقنيّين للعمل المسرحي. وقدم المسرح مجموعة من الأعمال مثل: «الملك هو الملك»، «إكسدنت موت فوضويّ»، «عبير»، «إضراب مفتوح»، «جزيرة المعز»، «أذكر»، «بيت السيّدة»، «زغرودة الأرض»، «سحماتا»، «رقصتي مع أبي»، «مشهد من الجسر»، «بؤس ورعب الرايخ الثّالث»، «أحلام شقيّة» و«حلّاق بغداد».
الخلاصة
باستعراضنا لهذه الحركة المسرحيّة الفلسطينيّة نلاحظ أنّ الأعمال الفنيّة تفاعلت تفاعلاً حيّـًا مع الجمهور بحيث ظهر منها الغثّ والسّمين وفقًا لمتطلّبات الجمهور والمواضيع الّتي عالجتها هذه الأعمال. وتبقى المعادلة المثيرة للحيرة تشغل بال المهتمّين بالمسرح وهي: هل تقدّم المسارح ما يريده الجمهور أم أنّ الجمهور يقبل المسرحيّات الّتي يعدّها الفنّانون لأجله؟
كما يبقى التّساؤل مطروحًا حول جودة العمل والميزان الّذي نقيس به هذه الجودة، ليصبح لدينا مسرحًا مرموقًا. وهذا ينطلق من أن المسرح يحتاج إلى جمهور، ويتمّ اللّقاء بين المسرح والجمهور إذا خاطب هذا المسرح جمهوره.. فإذا انعدم الخطاب واللّقاء المباشر بينهما تلاشت العملية المسرحيّة. وعليه يجب أن نقيس الأعمال المسرحيّة النّاجحة هي الّتي خاطبت الجمهور. وهذا ما حلّ بالمسارح المختلفة الّتي عملت من منطلقات تجاريّة أو تجريبيّة أو تشغيليّة، ولكنّها لم تحرص على هذه المخاطبة الصّادقة والمباشرة الّتي تحفظ للمسرح بقاءَه ودوامه، وبالتّالي جدارته بالتّسمية «المسرح العربيّ». ولذا نجد أن بعض المسرحيّات الّتي خاطبت الجمهور لاقت نجاحًا في عروضها، وكانت هذه أقليّة.
ومع كلّ هذا التّاريخ الفنّي منذ مطلع القرن العشرين وحتّى اليوم نرى أنّ المسرحيّات والمسارح الّتي عملت في الساحة الفلسطينيّة كانت مجرّد محاولات لظهور حركة مسرحيّة ثابتة ودائمة العمل والحضور، ولم تفلح كلّ هذه الجهود بالرّد على السّؤال: هل أصبح لدينا مسرح فلسطينيّ؟
للرّد على السّؤال أعتقد أنّ المقولة: «المسرح يرافق الحضارة» يمكنها أن تردّ ردًا صحيحًا إذا اعتبرنا أنّ أعمالنا الأدبيّة والفنيّة والاجتماعيّة والفكريّة تنصب في الإطار الحضاريّ الواسع. وقد تثبت هذه المقولة بأنّنا لا نزال في الطّريق نحو الهدف والّذي لم يتحقّق بعد!!