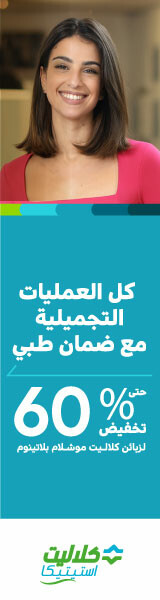عقد قسم اللّغة العربيّة وآدابها في جامعة حيفا، يوم الخامس من حَزِيران الجاري، ندوةً مع الشّاعر رشدي الماضي، دعا فيها طلّاب اللّغة العربيّة، عربًا ويهودَ، إلى لقاء الماضي بشكل شخصيّ ومباشر.
وتأتي هذه النّدوة ضمن النّشاطات والفعّاليّات اللّا-منهجيّة الّتي ينظّمها قسم اللّغة العربيّة وآدابها في الجامعة، حيث تتمّ دعوة الطّلّاب للقاء أحد الأدباء المحلّيّين.
وقد بادرت إلى عقد هذه النّدوة وتنظيم اللّقاء الدّكتورة كلارا سروجي – شجراوي. يُذكر أنّه قبل انعقاد النّدوة وتنظيم اللّقاء، تقوم د. كلارا بالاطّلاع على مؤلّفات الشّاعر أو النّاثر المدعوّ، والتّجوال في المواقع الإلكترونيّة المختلفة، لتعرّف جوانب حياته ونشاطاته، حيث تقوم بدراسة شاملة وقراءة معمّقة قبل دعوته للنّدوة؛ إضافةً إلى لقائه مرّة أو اثنتين لجلسة مطوّلة، حيث تناقشه في المواضيع كافّةً الّتي ستطرحها في لقائه مع الطّلّاب، فتزوّده بالأسئلة والتّساؤلات مسبّقًا، للاطّلاع عليها.
وقد حضر اللّقاء، الّذي عُقد على شكل ورشة حواريّة، مجموعة من طلّاب وطالبات قسم اللّغة العربيّة وآدابها في جامعة حيفا؛ ومن بين الحضور برزت، أيضًا، نخبةً من محاضري القسم، منهم: النّاقد الپروفِسور إبراهيم طه، الپروفِسور رؤوبين سنير، الدّكتور إبراهيم جريس، وآخرون.. إضافةً إلى د. كلارا الّتي أدارت الحوار بشكل ناجح ومثير للإعجاب.
وقد تخلّل النّدوة – إضافةً إلى طرح الأسئلة والنّقاش – عرض شرائح خاصّة من إعدادها، تناولت سيرة الشّاعر الذّاتيّة بصورة شاملة، ونماذجَ من شعره، حيث قرأت هذه النّماذج قراءةً فنّيّة.
وقد تمحور اللّقاء حول العديد من القضايا والجوانب الفنّيّة والجماليّة والرّمزيّة أيضًا، الّتي يتضمّنها نِتاج الشّاعر رشدي الماضي، خصوصًا قضيّة الأسطورة، بصورة مكثّفة وبارزة، ما يؤدّي إلى تكثيف عنصر الغموض في شعره.
وبعد انعقاد هذه النّدوة في جامعة حيفا، كان لي مع الشّاعر رشدي الماضي هذا الحوار؛ لتعرّف رموز وجماليّة وجوانب شعره والتّعريف به.
– من الواضح أنّ للأسطورة حصّة الأسد في شعر رشدي الماضي، هل لك أن تفسّر لنا سرّ ذلك؟
الماضي: اُؤمن بأنّ الأسطورة هي بناء تعبيريّ يعود بخلفيّته إلى العنصر التّاريخيّ، وكبناء؛ فهو يحوي عنصر الفنّيّة والجماليّة في الكتابة، ومن خلاله يتمكّن الشّاعر من الاستضاءَة بالماضي لشرح الحاضر والتنبّؤ بالمستقبل، أيضًا؛ وذلك من خلال إيماني بأنّ الشّاعر – لسبب انخراطه في واقع مجتمعه – يؤسّس لوجود بديل، باللّغة والوطن، وكلّ شيء.
– وماذا بالنّسبة إلى كون حيفا عنصرًا مركَزيّـًا وأساسًا في شعر الماضي، أيضًا؟
الماضي: حينما أستعمل الجزء من هذا الوطن، فالمقصود، أساسًا، هو الكلّ، حيث إنّ حيفا تسكنني عشيقةً ومعشوقة، لذلك أحاول – من خلالها – أن أوصل رسالة تعلّقي بها وبالوطن الكبير، تعلّقًا لن يدانيه النّضوب.
– كثيرًا ما يبرز استخدامك الرّمزيّة المكثّفة في شعرك.. فهل تقصد – من وراء ذلك – الكتابة لنخبة معيّنة؟
الماضي: إنّني – بصورة أساسيّة ومتعمّدة – أكتب للجميع، وذلك من خلال منطلقي الفكريّ، الّذي يستند إلى ويتّكئ على نداءٍ دائم أوجّهه إلى القرّاء الكرام، إلى ضرورة عدم طلبهم من الشّاعر أن يهبط إلى المستوى العامّ؛ بل على القرّاء أن يرافقوه جنبًا إلى جنب، كي يرتفعوا جميعًا إلى المكانة الّتي تؤهّلهم للوصول إلى العتبة الثّقافيّة، الّتي يلجون منها إلى مسيرة الإبداع الحضاريّ العالميّ.
– وعلى ذكر الرّمزيّة.. فما الّذي يدفعك إلى استعمال رمز المسيح بشكل مكثّف في شعرك؟
الماضي: إنّ الرّمز – بغضّ النّظر عن كونه دينيّـًا أو تاريخيّـًا أو تراثيّـًا – مُلك للجميع. من هذا المنطلق، أنا أرى إلى خصوصيّة الرّموز الدّينيّة أنّها تشكّل جزءًا عضويّـًا من البُنية الفكريّة والثَقافيّة الّتي أمتلكها؛ فعلى سبيل المثال، حقيقة موت المسيح على الصّليب ثمّ قيامته، هي الرّمز الأفضل الملموس لموضوعَيِ القيامة والبعث – حسَب رأيي – رغم وجود أسطورة "طائر الفينيق". أنا أتعامل مع الرّموز كافّة في شعري – بغضّ النّظر عن انتمائها الدّينيّ – على أنّها رموز تشكّل جزءًا ومُركّبًا أساسيّـًا في منظومتي الفكريّة كشاعر.
– وماذا عن المرأة والجنس في شعر الماضي؟
الماضي: يبحث كلّ شاعر، عادةً، عن الآليّة الأدبيّة التّعبيريّة والفنّيّة، الّتي من خلالها يجعل ما يكتبه رسالةً دلاليّة وصورةً ملموسة بالنّسبة إلى القارئ. وفي رأيي، علاقة الرّجل والمرأة أشبه بعلاقة الماء والهواء؛ فمن خلال الحديث الّذي يبدو، ظاهريّـًا، كأنّه توجُّه إلى الحبيبة، هو في باطنه توجُّه صادق إلى القضيّة الّتي تسكنني كشاعر. فعلى سبيل المثال، ليس هناك أجمل من إبراز عنصر الحبّ والعشق والوَلع بالنّسبة إلى الوطن، من التّعبير والتّوجّه بالحديث إلى علاقتي مع المرأة بهذا المفهوم.. بذلك أصل إلى فكر الشّاعر وأحاسيس القارئ، بغضّ النّظر عن عمره.
– أفتقد، أحيانًا، فِلَسطين في شعرك، رغم وجودها بشكلٍ مبطّن في بعض أشعارك..
الماضي: كلامك صحيح. ولكن لا شكّ في أنّ القضيّة الفِلَسطينيّة تسكنني بكلّ جوارحي ومشاعري وتلافيف فكري؛ ولكن ما يجب أن يحذر منه المُبدع هو ألّا يحوّل قضيّة سامية أو مصيريّة كقضيّته إلى وظيفة. من هنا يمكن للقارئ المتمعّن أن يلمسَ فِلَسطين في كلّ ما يُكتَب، ولكن يجب ألّا يغيب عن بال أحد أنّ المبدع الحداثيّ يتوق إلى ما يُعرف بكسر الحدود للوصول إلى أكبر عددٍ ممكن من شرائح وقطاعات الشّعوب المختلفة، وهذا ما يجعله يوظّف في شعره الرّموز الّتي تحمل السّمة العالميّة للإنسانيّة؛ حيث يجعل من نصّه مقبولًا ومُتماهيًا مع كلّ قارئ، بغضّ النّظر عن مكان سكناه، خصوصًا أنّ الحداثة – بجوهرها – هي رسالة عالميّة فوق كونيّة. فنحن، اليوم، كأفراد لسنا مواطني دولة بحدود معيّنة فقط، إنّما كأفراد مفكّرين ومبدعين في هذا العصر، عصر الثّورة التّكنولوجيّة، أصبحنا – شئنا ذلك أم أبينا – مواطني العالم.
– ما مدى تأثير الشّعر في مجتمعنا، اليوم.. فهل يمكنه أن يكون أداةً لبناء مجتمع أفضل؟
الماضي: ثبت – على مدى تاريخ مجتمعنا العربيّ، بدءًا من العصر الجاهليّ حتّى يومنا – مدى تأثير الكلمة كإيقاع وموقف ورسالة، وكرافعة نهضويّة في الإنسان العربيّ. ومن الواضح أنّه في أكثر من حِقبة لعبت الكلمة دورًا أساسًا في تثوير الجماهير وتعبئتهم، والتّماهي مع قضيّة اجتماعيّة أو ثقافيّة أو سياسيّة معيّنة. ويكفي أن نذكر مكانة الشّاعر في العصور العربيّة السّابقة؛ حيث كانت القبيلة تحتفل بميلاد شاعر فيها. هذا لا يعني أنّ قدرة التّأثير وطاقته كانتا بالقوّة نفسها وبالحجم نفسه في جميع المراحل، ولذلك نشهد تراجعًا في بعض هذه المراحل، خصوصًا المتأخّرة منها؛ وذلك لأسباب خارجة عنّا، أحيانًا.
فبرغم هذا الزّمن الرّديء الّذي تعيشه الكلمة والثّقافة، هذا لا يعني أن نتوقّف عن العمل بكلّ ما أوتينا من إيمان وطاقة لهدف إبقاء الكلمة في طليعة ومقدّمة الصّوت الصّادق والمؤثّر، الّذي سيعود ويمثّل مكانته – بل وأكثر – في مسيرتنا النّضاليّة، الّتي نؤمن بأنّها ستؤتي أُكُلَها، نجاحاتٍ وانتصاراتٍ، في أكثر من مجال.. لذلك أُؤمن بأنّ الكلمة ستبقى المنارة في خندقنا الثّقافيّ والنّضاليّ.
وفي نهاية الحوار عاد الماضي وثمّن عاليًا مبادرة قسم اللّغة العربيّة وآدابها، الّتي أتاحت له المجال للقاء الطّلاب والأساتذة والتّحاور معهم، مؤكّدًا أنّ عقد مثل هذه اللّقاءات يساهم، بصورة ناجعة ومباشرة، في إزالة الحواجز بين المُبدعين والمثقّفين وجمهور القرّاء، وإنْ كان يخدم ذلك شيئًا أو أحدًا فإنّما يخدم ثقافتنا العربيّة المحلّيّة. كما شكر – بشكل خاصّ – د. كلارا على جهودها المميّزة، وإدارتها الحلقة الحواريّة بنجاح.