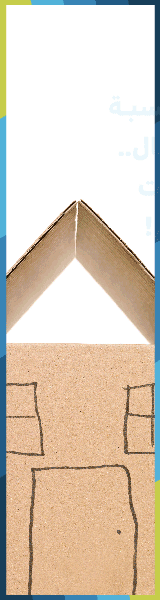أمسية مناقشة كتاب “حياتي معركة لم تنته بعد”

وضع الكاتب والإعلامي نايف خوري كتابا عن عمّه بولس نايف خوري، وحياته التي امتازت بالشقاء وصلف العيش، حتى يومنا هذا. وقد كان مقررا في نادي حيفا الثقافي التابع للمجلس الملي الأرثوذكسي الوطني مناقشة الكتاب في العام الماضي، ولكن جائحة كورونا أوقفت نشاط النادي حتى يومنا هذا. وعاد النشاط ليتجدد بمناقشة هذا الكتاب. وتولّى الكاتب والإعلامي نايف خوري عرافة هذه الأمسية وقال فيها:
حياتي معركة لم تنته بعد، هو مجمل حياة العم بولس أبو وليد، منذ طفولته وحتى اليوم تقريبا. كلانا، هو وأنا، نسكن في نفس العنوان، ونفس الدار، ونفس الطابق السكني، والباب بالباب. أطرقُ بابَه كل يوم، أجالسُه، أستمع إليه أكثر مما أُسمعه مما لدي.. ولاحظت أن لديه الكثير الكثير مما يجدر توثيقه، فحملت آلة التسجيل وأخذت أسجل أحاديثَه كل يوم، واستعرضنا ردحًا من حياتِه وتجربتِه، في إقرث مسقطِ رأسِه فترة الطفولة، ونزوحِه إلى لبنان، وعودتِه إلى البلاد شابًا يافعًا، وكفاحِه الذي استمر طيلة حياتِه، لكي يؤمّن لقمة العيش لعائلتِه. فهو يبلغ اليوم السابعةَ والثمانين من العمر، إلى أن حلّ يومٌ كان بمثابة إنذارٍ لنا في العائلة، فأصيبَ بجلطةٍ دماغية، أقعدته عن الحركة، وشلّت يدَه ورجلَه.. تابعنا الحديث بعد مغادرته المشفى بنهمٍ وشغفٍ أكثر، وهو يحاول تحديدَ الأحداثِ وتوضيحَ ما جرى له عبرَ هذه السنين.. وإذ بسكتةٍ دماغيةٍ أخرى تصيبُه فتقعدُه عن الحركةِ أكثر، وتعقدُ لسانَه عن الكلام. ولم يَعد بوسعِه الحديثَ بوضوح، بل يمكنه أن يسمعَ الحديث بانتباهٍ ووعيٍ تامّين، ويحاول المشاركة ببعض الكلمات، ولكن بصعوبة. ولذا يتعذر عليه حضور هذه الأمسية، وسننقل إليه تسجيلها، بالصوت والصورة لنسمعها معا، ومن هنا نبعث له باسمكم جميعا، التحية والتقدير، والصلاة لشفائه، والعمر المديد.. ولا ننسى تحية إجلال وإكبار لزوجتِه ورفيقةِ دربِه أم وليد، التي استطاعت أن تقومَ على خدمتِه ليلا ونهارًا، ولا زالت، رغمَ تقدمها في السنّ، واحتمالِها أقسى الظروف وأصعبِها. فالتحية والتكريم لأم وليد.
حياتي معركة لم تنته بعد، كتابٌ تكفّلَ أبناء العم بولس البررة بإصدارِه، وهم يقدّمونَه هديةً ويرصدون ريعَه للنادي الثقافي.. فلهم جزيلَ الشكرِ والامتنان.. ومن يرغب باقتناء الكتاب يُطلب من النادي.. وهنا المجال لنقدم شكرنا الجزيل لإدارة النادي، أعضاء المجلس الملي الأرثوذكسي .
وقد تحدّث في الأمسية الكاتب والمربي سهيل عطا الله الذي قال:

قصص ومخزون ذكريات، وفورات حنين يتنفّسها كل مهجّر من وطنه الصغير ووطنه الكبير.. قصص وومضات يرضعها القرّاء حليبًا صافيا طيّبا من أثداء صديقين قريبين من قرية مهجرة كان اسمها إقرث، وما زالت تنبض ألقًا في عروق أهلها وأحبائها.
على سطور الكتاب يفتح نايف مع عمّه مدرسة صفوفها توثيق للجذور ومساقاتها مناهج لربط الأصلاء بالأصول. ولا أغالي إذا ما قلت إن الكتاب فصول من السيرة الذاتية لرجل تتمثّل في شخصه قصص الترحيل والتهجير التي حيكت لشعب أصلاؤه أمسوا دخلاء.
عندما نقرأ الكتاب نجده صفحات خالية من الشكليات وأنماط التكلّف.. إنه مجموعة وقائع تخرج إلينا دونما فذلكات أو فبركات.. إنه نتاج تجارب حياتية عاشها ويعيشها أبو الوليد ونعيشها نحن معه. ذكريات أرادها ونريدها أن تبقى في ذاكرة أجيالنا حاضرا ومستقبلا، فنحن كما قال المبدع سلمان ناطور طيّب الله ثراه: إن فقدنا الذاكرة، إن أضعناها أكلتنا الضباع.
حكايا كتاب “حياتي معركة لم تنته بعد” تختصر قصصا يعيشها المُستلَبون، وقصص المنهوبين المشرّدين المشتتين في خيام الشتات وبلاد البؤس والشقاء.. قصصا يتنفّسها أبناؤنا لينتصبوا قامات تعتمر الصبر والصمود في مجابهة مكائد الخادعين.
في مداخلتي هذه عن الكتاب أشير إلى ما هنالك من اختلاف بين الصورة الذاتية والصورة الغيرية.. في الكتاب نلتقي محدّثا يرسم الواقع كما هو.. واقعا من فم رجل تتحوّل لديه الخاصة إلى موضوعية عامة.
كل قصة هنا يمكن أن تخرج من فم أي مهجّر هجّرته النكبة وشتّته الظالم اللعين.. إن ذكريات أبي وليد يعتمرها ويردّدها آباء وأمّهات الفلسطينيين القابعين في الوطن المنتهك. ويستطيع كل قارئ فلسطيني ولد مع النكبة وقبلها ورأى النور بعد النكبة أن يغرف من ينابيع هذا الكتاب ماء سلسبيلا.. ماء زلالا، يملأ أباريق وجرار المشردين في وطن فلسطيني تأكله أنياب الظالمين.
في كتاب نايف الراوي لرواية عمّه غذاء لذاكرة كل فلسطيني لا يعرف إلا التشبّث بأهداب الوطن وتحويل المعاناة إلى الحرّية رغم مرارة الحياة وقسوتها.
إن الروح الوثّابة النابضة في قصص الكتاب، على صدقها وبساطتها، ستبقى منصّة مِن عليّها تعتلي أنفاس شباب الوطن صهوات خيول ستدك سنابكها قلاع الجائرين الناهبين السالبين.
لا بدّ هنا من الإشارة إلى الدقة التسجيلية لدى نايف التي تعزّز المصداقية في الكتابة.. فالعلاقة في بيت المرحوم أبي فايز مع معرفة تضاريس إقرث بأسماء حواريها جاءت مرآة تعكس واقع الأحوال، ما تعكسه المرآة ليس ذكريات عابرة للوعي في مراحل عمر معدّي هذا الكتاب بقدر ما هي قائمة على حقائق عصية على النسيان وباقية مصدر إلهام لجيل فلسطيني يتلمّس خطاه على دروب الحياة مبتغيا تحويل الآمال إلى حقائق وأفعال.
كما يحفظ صاحب السيرة أسماء أحبائه من أقارب وجيران وأهل بلد. يحفظ أبو الوليد أسماء القرى المجاورة لبلدته: تربيخا، سروح، النبي روبين، ومعها يحفظ أسماء قريته وقريتنا كالقرقود والخانوق وعين منتنة وحارونا والصوانة وكسبر ومعاريا ومرج سارة ومشمش وغيرها وغيرها، وكأنه يريد بهذا أن يعلّم أبناءه وأولاد بلده تضاريس البلد لتبقى حية في الذاكرة.
من يتابع معركة حياة بولس التي لم تنته يجده يدفن أحاديث غولدا مئير في سبعينات القرن الماضي، عندما قالت مؤبّنة إقرث: إن المسنين أبناء الجيل الأول سيموتون، وأبناء الجيل الثاني ستذوي عزيمتهم ورغبتهم بالرجوع، أما جيل الأبناء والأحفاد فسيذهب بهم النسيان.. نسيان بلد كان اسمها إقرث.
سيبقى هذا الكتاب صخرة تتكسّر عليها أفكار الظالمين أمثال غولدا مئير ومن ينضوي تحت ألويتها.
ثم تحدث البروفيسور عماد قسيس قريب العائلة وقال:

من يقرأ هذه المدوّنة يكتشف حالًا أنّها ليست نَصًّا أدبيًّا خياليًّا يمكن أن نقيّمَه من خلال اللغة والمفردات والصور والبلاغة أو الحبكة السرديّة، لأنّه في الحقيقة قصّة واقع معاش وشهادة عصر أشبه بنصوص ملحميّة تحكي تغريبة بني إقرث، التي تأبى، رغم مرور سبعينيّة ونيّف من السنين، أن تتركَ مسرحَ الحياة، بل تنتعش كلّ يوم من جديد وتبقى متربّعة على صدور من تنكروا لضميرهم وحسّهم البشريّ حبًّا في السيطرة التامّة على التاريخ والجغرافيا.
لم تجرَ أبحاث خاصّة على أهل البلد لمعرفة التأثيرات النفسيّة فيهم بعد الترحيل القسريّ، بل ولن تجرى أبحاث على نفسيّة الدور الأوّل والثاني والثالث بعد كارثة التهجير وهدم البيوت.
ولكن مع مرور السنين بدأت أراجع الأحداث وأفهم صمت الطفولة ومشحة الحزن التي ارتسمت على وجه والدي طول السنين، بدأت أفهم ذاك الصمت وأحترمه وأفهم كم هو ممزوج بالحنان والعطف على أبناء لم يعاينوا قريتهم الطبيعيّة، بل عاشوا في بيوت كانت تتغيّر من حين لآخرَ حسب الظروف، فكانت عمليّة الرحيل والتنقل جزءًا له عمقه النفسي من تلك الأيّام.
استغرقت سنين طويلة لأستوعب سبب جلوس الأمّ في مدخل المنزل في هاجعة الظهيرة تنظر للأفق، تطلق صوتها بتراتيلَ فهمت منها أنها نواح على ماض هدمَ بعنف. ولكن، كما يقال في كلّ شيء حزين مسحة فرح.
قرأت الصفحات الأولى بنهم شديد وبفرح غريب لا يليق بقراءة لسيرة ذاتيّة تتحدّث عن كارثة عامّة حصلت ذات يوم. كانت هذه الصفحات تعيد لي ذاكرتي المسلوبة قبل ميلادي، فتجوّلت في الحقول وزواريب القرية وانتقلت بحرّيّة بين إقرث والقوزح ومروَحين والقرى المجاورة، تنعّمت من بساتينها وتنفست هواءها وتعرّفت مجدّدًا إلى حياتها وموادّ البناء الأساسيّة لهذه الحياة، والأرض وأدوات الفلاحة والعادات والأسفار والأعراس والمآتم والأحداث التي كانت تسجّل تاريخ الضيعة، فكانت هذه الصفحات كنزًا عظيمًا لمعلومات عادت لذاكرتي المسلوبة قسرًا قبل أن أولد.
قبل حين؛ كتبت إثر وفاة بعض أبناء إقرث ممّن كانوا شاهدين على تلك الأيّام، معبّرًا عن خوفي من فقدان الذاكرة الجماعيّة وضياع الماضي في المستقبل وابتعاد الأجيال. هذا الابتعاد الذي عوّلَت عليه النائبة عن الحركة الصهيونيّة ذات يوم بأنّ الجيل الأوّل سيموت وتنسى الأجيال التالية ما حصل، فتحصل غولدا مئير على “البيظة والتقشيرة”، كما كان يقول أهلنا فيما مضى من الأيّام.
وهنا يكمن السبب الأوّل في أهمّيّة هذا الكتاب؛ فهو، وإن كان سيرة ذاتيّة خَط فيه العمّ بولص ذكرياته، فإنّ أهمّيّته تتعدّى ذلك بكثير.
شاهد العصر عايَنَ الأحداثَ ويكتب بذاكرة “تفلق الصخر”، رغم مرور السنين، عن حياته ولكنّه يظهر من خلالها، تفاصيل حياة “رعية” متميّزة لها إيمانها وقوّتها وحيويّتها. وإن كانت الكتابة بالفصحى إلّا أنّها لغة خفيفة سلسة تسهل قراءَتَها- رغم أنّني بحكم معرفتي بالمتحدث- كنت أتخيّل من خلال القراءة العم بولس وكأنّه يتحدث بلغته العامّيّة على سجيّته المعهودة، فلم أهتم كثيرًا بالإطار كاهتمامي بالقصص والحكايات والمفردات التي طالما كنت أصطادها لأنظم بها الشعر باللغة المحكيّة. ولا بدّ لمن كان شاهدًا على العصر، أن يكتب بأدقّ التفاصيل تلك اللوحة الحياتيّة، التي تعكس ملحمة أهل البلد وكلّ البلدان والقرى، التي عانت من التهجير القسريّ وفقدان الأرض والمساحة، التي كانت البيئة الطبيعيّة لمجموعة بشريّة مميّزة، لها طابعها الخاصّ ولها الملكيّة غير المقتصرة على الأرض فقط بل الملكيّة الروحيّة على حضارة خاصّة اقتلعَت من الجذور، ولكنّها تأبى أن تذويَ وتذبل.
أما النصف الثاني من الكتاب؛ ذاك الذي يتحدّث عن التهجير والتمزيق القسريّ ومن بعدها الحياة الصعبة في الغربة، فكان عليّ قراءته بشقّ النفس.
قرأ ت القسم الأوّل في سهرة واحدة، وما أن وصلت إلى سرد أحداث مسيرة درب الآلام، حتّى بدأت تنتابني مشاعر مختلفة من حزن وحنين دافق، جعلتني أقرأ بقيّة الكتاب على مراحلَ متعدّدة. ليس من السهل استعادة الأحداث نفسيًّا، لأنّها تعيدنا إلى ذاكرة الطفولة والشعور بانعدام العدالة، وانهيار القيَم البشرية، دون أن تجد ما يطفئ النارَ الداخليّة، إلّا أنّنا نجد هناك من أحببناهم ورحلوا عنّا.
منذ بدأ ت قراءة الكتاب كنت أتساءل في كلّ لحظة: “ترى كم كان عمر أبي؟ في أيّ حقل كان يزرع تلك الأيّام؟ في أيّ واد كان يقطع الحطب والفروع اليابسة للتدفئة في الشتاء؟ كيف كان ينتقل بين إقرث والقوزح والقرى القريبة؟” وألف سؤال وسؤال كان يمرّ بخاطري.
تلك هي الحقول التي كان أبي يتجوّل فيها، وهذه هي عين الماء والبئر، وهذا هو الشاكوش والسّدان الذي كان يصلح عليه حذائي، وذاك هو المعول الذي كان يضرب به الأرض فتعطي من خيراتها ما يكفيه ويكفي عائلته وها هو الغربال الفروط لا يزال معلقا على الحائط والقدّوم الذي يحفي فيه الأرض ليغرس المشاتل حول البيت.

هنا تكمن قوّة الكتاب في رسم مربّعات فارغة في الذاكرة أو بالأحرى مربّعات من فسيفساء الماضي الذي كان من المفروض أن أكون جزءًا منه مع مرور الأيّام… ولكن لا؛ فالحياة قرّرت لي مساراً أبعد وأوسع.
ثم اختتمت الأمسية بمداخلة للدكتور سليم خوري، قريب العم بولس، والمشرف على معالجته مباشرة. وتحدّث عن “إضاءة على الجوانب الخفيّة للصراع والتهجير والصحة العقلية للمهجّرين”، وعن الضغط النفسي الذي يتعرّض له اللاجئون، فقال إن النزوح بأشكاله هو صدمة نفسية للمرء، وكم بالأحرى التشريد الذي يُفرض قسرًا على الناس. وقد أدركت شعوب العالم هذا الأمر فتأسست الهيئات الأممية المختلفة لمساعدة اللاجئين وإعانتهم على اجتياز مراحل اللجوء.
وأضاف قائلا إن المعاناة التي تواجه اللاجئين تتراكم مع الضيق الاقتصادي والنفسي والصمت مع التأهّب، ونظرة الوجع والألم التي لم يجد أبي المهجّر لها جوابا. وإن الانسلاخ عن شبكة الدعم المكاني والأسري يتعدّى الانتماء الذي كان له تأثير على شخصيته وحياته بجوانبها. ومكوّنات الهوية متعلّق بالمكان، فالمكان حيّ فينا، وإن نزحنا عنه يتألم ونحن نتألم معه.
إن الصحة العقلية والنفسية للمهجّرين مغيّبة بالأبحاث العالمية، وهذا يعود إلى الخلفية الثقافية والدينية والصحية للمهجّر. وقد لا نلاحظ الفرق بين المهجّر والنازح، فالنازح قد يتمكن من بلورة حياته مجدّدا في بلد النزوح، بينما المهجّر، يواجه صعوبات جمة في حياته وخاصة مسألة الانتماء. وكتابنا هذا يتطرق إلى مجمل حياة هذا المهجّر، وكيفية محاولاته المتكرّرة كي ينتفض ضدّ الظلم وضدّ الحسرة وتأجيج الحنين في النفس.
والنزوح الداخلي يفتقر للحماية القانونية، لأنه بدون تعريف قانوني واضح. والجيل الأول الذي أخرج من إقرث، شعر بأن الاحتلال سلبه هويته وانتماءه وكل تعلقه ببلده، وأصبح يعاني من ضيق نفسي خاصة أنه شعر بأن الاحتلال غرّر به، وكان ينتظر وفاء الوعد بالعودة بعد أسبوعين.. ولكن هذا لم يتمّ.
أما الحنين فقد يؤدّي إلى ألم نفسي، بل قد يبلغ درجة الوسواس. فهل سنعود يوما؟ ومن سيعود؟ وما طبيعة البلدة التي ستعود؟
وفي الختام وقّع الكاتب نايف خوري على الكتاب لعدد من الحضور.
جميع الصور أدناه بلطف من نادي حيفا الثقافي