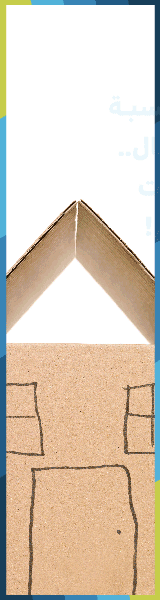التجذُّر المسيحي في كنائس الشرق في الأمس واليوم
• يوم وُلدت الكنيسة وُلدت معها فكرة التجذّر المسيحي واستطاعت أن تتفاعل فكريَّا وثقافيًّا ومعيشيًّا في المحيط الذي تنتشر فيه، وأصبح المسيحيون في الشرق، عمّال الساعة الأولى في هذه العملية التي بدأت في أورشليم حيث رُجِمَ القديس إستفانوس أول الشهداء.
• بعد موت استفانوس تشتت المسيحيون في الأقطار المجاورة، كما يذكر كتاب “أعمال الرسل”: ذهب بعضهم إلى المدن المجاورة لأورشليم، وبعضهم الآخَر إلى دمشق، حيث أسَّسوا كنيسة قوية دبّت الرعب في قلوب يهود أورشليم الذين خافوا على ديانتهم، فأرسلوا شاول المضطَهِد الشهير للمسيحية ليُلقيَ القبض على كل يهودي يعتنق المذهب الجديد.
• وفي سنة 37 للميلاد، كانت كنيسة أخرى قد مدّت جذورها وكَثُرَ أتباعها في مدينة أنطاكية، حيث دُعِيَ المؤمنون بالمسيح مسيحيين. وامتد انتشار الكنيسة إلى مدن أخرى، فتجسّدت مع مرور الزمن، وبفعل الروح القدس، الوحدة والتعددية في تجمُّعاتهم وصلواتهم وتنظيمهم.
• حدث ذلك يوم العنصرة، يوم مولد الكنيسة، إذ يخبرنا مؤلِّف أعمال الرسل أنه وُجد في أورشليم ثمانية عشر شعبًا رأوا وسمعوا وعاينوا حلول الروح القدس: “وكان نازلاً في أورشليم يهود، رجال أتـقياء من كل أُمّة تحت السماء. فلما سمعوا ذلك الصوت تجمهروا وأخذتهم الحيرة وقالوا: كيف نسمع، كل منّا، لغته التي ولد فيها نحن البرتيين… وسكان ما بين النهرين وكبادوكية والبنطس… والكريتيين والعرب” (2: 9-11).
• هذه التعددية التي بدأت في أورشليم، ظهرت أيضًا في أنطاكية المدينة المترامية الأطراف التي كان يعيش فيها جنبًا إلى جنب السوريون واليهود واليونان والرومان. مما حمل الأب كوربون في كتابه “كنيسة العرب” إلى القول: “إن كنيسة أنطاكية وُلِدَت تحت علامة التعددية، وما زالت بعد ألفي سنة، تعدّدية”. هذا ما جعل قداسة البابا بولس السادس يقول في الخطاب الذي ألقاه في مدرسة اليونان في 30 آذار سنة 1977، بمناسبة الذكرى المئوية الرابعة لتأسيسها: “إن الكنائس الشرقية عاشت التعددية وسبقت الأبحاث المعاصرة الداعية إلى توثيق العلاقة بين التبشير بالانجيل والمدنيات المعاصرة، أي بين الإيمان والثقافة، واستطاعت أن توجد تيارًا فكريًّا عقائديًّا، وصورًا ملموسة لفكرة التعددية والوحدة”.
• صحيح أن اللغة اليونانية قد لعبت دورًا فاصلاً في حياة الكنيسة، كلغة العهد الجديد والمجامع المسكونية، وكتابات آباء الكنيسة، والليتورجية، ولكنها لم تكن العامل الوحيد في الحياة الثقافية واللغوية الشرقية. ذلك أن الديانة المسيحية التي بدأت باستعمالها قد شجّعت في الوقت ذاته اللغات والثقافات القومية في مصر مثلاً (الأدب القبطي) وفي بلاد ما بين النهرين وسورية، حيث أصبحت اللغة الآرامية المتمركزة في مدينة الرُّها لغة الأدب المسيحي، طوال اثني عشر قرنًا. وكذلك القول عن جورجيا حيث ظهر الأدب القومي بدافع اعتناق شعوبها الديانة المسيحية، وفي أرمينيا حيث وضع المسيحيون أبجديتها، فأصبحت لغة الحضارة والثقافة.
• هذا التنوّع اللغوي الثقافي امتدّ طبعًا إلى الحقل الديني فنشأت في كل مدينة، وفي كل منطقة، عاداتٌ طقسية وتنظيماتٌ إدارية ومدارسُ فكرية (مدرستا: أنطاكية والإسكندرية) تختلف الواحدة عن الأخرى بمقدار تجذُّرها في التقاليد والثقافة المحلية. وقد استطاع التجذّر المسيحي، في تنوعه اللغوي والثقافي أن يُثبت وجوده في هذا الإطار الشرقي المتعدد الثقافات، ويعطي للكنائس المحلية نوعًا من الاستقلال الكنسي .
• على أن نور عملية التجذر والتعددية التي أينعت في الكنيسة الأولى وأعطت ثمارها الشهية، بدأ يخبو في القرن الخامس وما يليه، لسببين أساسيين ومهمّين جدًّا:
فقد نشأت نتيجة مجامع القرن الخامس المسكونية، تياراتٌ كنسية ولاهوتية باعدت بين الكنائس الشرقية، وضعضعت وحدتها، فأصبحت الكنيسة القبطية والسُّريانية والآشورية في وادٍ والكنيسة الملكية البيزنطية في وادٍ آخر.
ونشأت، من جهة أخرى، مواقف سياسية نجمت عن الفتح الإسلامي الذي عمّ المنطقة في القرن الثامن للميلاد وبسط سيطرته على الكنائس المحلية المنتشرة في بلاد فارس (إيران) وسوريا وبلاد ما بين النهرين ولبنان وفلسطين ومصر وتركية الشرقية. فانطوت على نفسها ودخلت في عزلة متبادلة بين بعضها، وفي عزلة شبه تامة عن الكنيسة الجامعة. وزادت هذه العزلة سوءًا إثر الحملات الصليبية التي جعلت كنيسة الغرب تتحاور مع كنيسة القسطنطينية وحدها وتسقط من حسابها الكنائس الشرقية الأخرى، مما جعلها معزولة ثقافيًّا وروحيًّا، عن الكنيسة الجامعة، وعاجزة عن القيام بأية رسالة تبشيرية.
• وقد يكمن الفرق بين نشاط كنيسة الغرب وضعف الكنائس الشرقية في كون الكنيسة الغربية شاطرت السلطة المدنية الغربية حضارتها وتفتّحها، نتيجة الانسجام الكامل بين البابوية وأباطرة الغرب؛ بينما كانت كنائس الشرق بعيدة كل البعد عن مشاركة الدولة الإسلامية في نظامها السياسي والاجتماعي، إذ أعطى الفتح الإسلامي مسيحيي الشرق صفة “ذميين” فارضًا عليهم نظامه الديني والاجتماعي والسياسي والثقافي، ومحرِّمًا عليهم دورهم التبشيري، تطبيقًا للشريعة الإسلامية.
• هذه الصورة القاتمة التي نستشفّها خلال هذه الحِقبة التاريخية والتي تعرض علينا انتقال هذه الكنائس الحية المنفتحة على العالم وثقافته في حوار يغني جميع الأطراف، إلى كنائس “مليّة” وطوائف همّها الوحيد أن تحافظ على بقائها، يعرضها علينا الأب أغناطيوس ديك في كتابه “ما هو الشرق المسيحي” بقوله: “إن كنيسة الشرق العربي فقدت دورها الهام الذي لعبته خلال القرون الستة الآولى وانقطعت علاقاتها مع سائر الكنائس المسيحية، وأصبحت تعيش في العالم العربي وكأنما في Ghetto/ الغيتو محرومة من كل نشاط في الحقل الاجتماعي، محصورة في وظيفتها الليتورجية.” وقد زاد الكنائس الشرقية ضعفًا، إنقسامها إلى شرقية أرثوذكسية وغربية كاثوليكية (مثل: كنيسة الروم الكاثوليك، كنيسة السُّريان الكاثوليك، كنيسة الأقباط الكاثوليك…)، فأصبحت مشدودة إلى ماضٍ زاهرٍ نابعٍ من تعدديتها، وإلى حاضر قد لا ينسجم تمامًا مع تاريخها القديم.
• لا يُنكر أحد مساهمة المسيحيين الفعالة في القرون الثامن والتاسع والعاشر للميلاد في تكوين الحضارة والثقافة العربيتين، إذ نقلوا إلى العربية التراث اليوناني الفلسفي والعلمي، وكذلك فعلوا في القرنين التاسع عشر والعشرين للميلاد من تاريخنا، إذ لعبوا في النهضة العربية دورًا سياسيًّا وثقافيًّا ولغويًّا هامًّا. وهذا برهان واضح على قدرة الكنائس الشرقية في متابعة عملية التجذر، والقيام بدور الخميرة في العجينة البشرية التي تستقبلها.
( يتبع )
التجذُّر المسيحي في كنائس الشرق في الأمس واليوم
مراسل حيفا نت | 02/07/2018