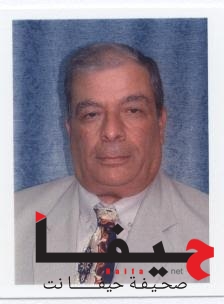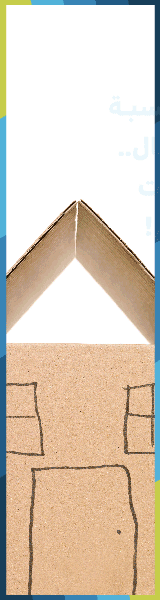“أُبّيلة” عيد الصليب
د. منعم حدّاد
كان درس الدين في تلك الأيّام يعطى في مدرسة القرية في الحصة الأخيرة من اليوم (الدراسي) الأخير من الأسبوع، وهي الحصة الأخيرة التي تُعلَّم أيام السبت، وبعدها كان ينطلق التلاميذ إلى عطلة نهاية الأسبوع.
وعندما يحلّ “عيد الصليب” يكون قد مرّ على افتتاح السنة الدراسية من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ولم يتعلم التلاميذ حتى يوم العيد سوى حصص قليلة من دروس الدين، لذا فمعلوماتهم الجديدة ليست وفيرة، ولم يحُل هذا بالطبع دون استعدادهم للاحتفال بعيد الصليب المقبل، فهم “ليسوا أولاد اليوم”، وما زالوا يذكرون كيف احتفلوا بالعيد في العام الماضي.
وما كادت تلك الحصة التي لم يكن بعض التلاميذ “مغرمين” بها ولا على علاقة ودّيّة معها تشرف على نهايتها، حتى ينطلق الجميع من غرفة الصف، انطلاق السهم من القوس، “مسفّحين” مهرولين ليباشروا الاستعدادات النهائية للاحتفال…
ويقترح أحدهم أن يتوجّهوا بادئ ذي بدء إلى “البيادر”، حيث كانوا يدرسون القمح المحصود ويذرون ما درسوا لفصل حبّات القمح عن التبن، ليختاروا مكاناً مناسباً منه لإيقاد “الأبيلة” فيه، لخطورة إيقاد “الأبيلة” على البيادر التي ما زال عليها “قصل”، أي عقد سيقان القمح التي لا تتكسر ولا “تنعم” أثناء درس القمح، فلا تصلح للتبن ولا علفاً للدوابّ، ولا يُستفاد منها إلا في إيقاد النار لحرق بذور الأعشاب الضارّة في مشاتل التبغ المزمع زرعها لاحقاً، أو في مواقد التدفئة.
ومن الشروط التي يجب أن تتوفّر في مكان إيقاد “الأبيلة” كان بُعدها عن أيّ ما يمكن أن يشتعل إذا تطاير بعض الشرر وطاله، (فالدنيا يابسة)، وقرب المكان من مصدر ماء ليتسنى إطفاء النار إذا خرجت عن السيطرة.
وبعد أن اختاروا الموقع على البيادر أو بين الكروم التي “دشرت وأقفرت” بعد انتهاء مواسم العنب والفواكه التي فيها، أسرع التلاميذ، بل الخلان من بينهم، إلى منازلهم، حيث بدّلوا ملابسهم بـ”ملابس عمل” وأخذ كلّ منهم مجرفة أو رفشأً أو منكوشاً أو دلواً أو “قفّة”،وتوجّهوا صوب المزابل القريبة من البلد.
وراحوا يحفرون في المزابل، فيزيلون الزبل الناعم، حتى يصلوا إلى “الربد”، وهو “صفائح” الزبل المتراصّ والمدكوك دكّاً، فيقتلعونها وينقلونها بما معهم من أدوات عمل، إلى “أرض الأبيلة”.
ويقوم فريق آخر منهم بجمع الحطب و”الشفّ” اليابس، وهو الفروع والأغصان التي سقطت أو احتطبت أو قطعت علفاً للمواشي، فأكلت المواشي ما كان عليها من ورق وتُركت العيدان لتجف وتصبح حطباً للنار، وكدّسوه أكداساً أكداساً فوق أرض “الأبيلة”…
وما أن حلّ الظلام حتى اجتمع الأهلون ليشاهدوا أولادهم يحتفلون بعيد الصليب، وعيد الصليب يحتفل به المسيحيون الذين يسيرون على “الحساب الغربي”(التقويم الغريغوري) في الرابع عشر من أيلول، ويحتفل به المسيحيون الذين يسيرون على “الحساب الشرقي”(التقويم اليولياني) في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وذلك في ذكرى رفع الصليب الكريم، الذي عثرت على خشبه القدسية هيلانة، والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، في العام 326 ميلادية كما يبدو، وإعادته بعد ذلك بحوالي ثلاثة قرون من الأسر أو السبي إلى القدس.
كما يعتبره الكثيرون من المسيحيين ومن غير المسيحيين من سكّان بلادنا وبلدان أخرى في الشرق الأوسط “رأس السنة الزراعية”، فيعقدون اتّفاقياتهم الزراعية مؤرّخة ب”عيد الصليب”، فيؤجّرون أرضهم ويستأجرون أُجَرَاءَهم “من الصليب إلى الصليب”.
وقبل أن يهرع بعضهم إلى أماكن الاحتفال، حيث ستوقد “الأبابيل”، وهي المشاعل الكبيرة التي توقد بمناسبة عيد رفع الصليب الكريم، صعد البعض على سطوح منازلهم، ووضعوا اثنتي عشر كومةً صغيرة من الملح، على اثنتي عشرة ورقة تين، كما يُقال، لكي “يرصدوا” النشرة الجوية للعام القادم، وليستطلعوا ما تخبئه الشهور التالية من حالات الطقس، فهذه “نشرة جوية سنوية”: يضع الناس الملح في المساء، وترمز كلّ كومة من الكومات إلى شهر من الشهور القادمة، ويتفقدون الملح في الصباح، فالكومة التي ذاب ملحها أكثر خلال الليل يتوقّع أن يكون الشهر الذي تمثّله تلك الكومة “رطباً” (أي ماطراً) أكثر من سواه، أما الكومات التي بقيت كما هي حتى الصباح فالشهور التي ترمز إليها ستكون جافة، بل جافّة جدّاً.
وبعد أن يفرغ “خبراء الأرصاد الجويّة” من مهمّتهم التي تعتمد عليها المواسم الزراعية القادمة، يتوجّه الجميع إلى أماكن إيقاد “الأبابيل”.
وتحيط كلّ جماعة ب”أبيلتها”، ويتقدم أحدهم من “الأبيلة”،ويتفقّد “تنظيم الأبيلة” وتكديس الحطب فيها بالشكل الصحيح، ففي الأسفل القشّ الجافّ اليابس، وفوقه الأغصان الدقيقة الهشّة، تعلوها الفروع الغليظة، وأكوام الرّبد، ويتناول بيده حزمة صغيرة “ملء الكفّ” من القشّ الجاف اليابس والناعم، ويدسّها تحت جانب كومة القشّ والحطب الهرمية، ثمّ يخرج من جيبه زناداً (زنداً) حديدياً مثّلث الشكل وحجر صوّان وقطعة “صوفان” (وهي قطعة من الفطر الذي ينمو على الشجر فيُقتلع ويُجفّف ويصبح مادة سريعة الاشتعال)، ويضع “الصوفان” على حجر الصوّان، ويمسك الزناد بإبهامه وسبّابته، ويروح “يقدح” ويوري الزناد، مرّة واثنتين وثلاثاً وعشراً… والشرر يتطاير إلى كلّ الأنحاء، حتى يقع بعضه على “الصوفان” و”يتشبّث بأهدابه” فيشتعل الصوفان، ويبدأ الرجل ينفخ فيه حتى يتحول الصوفان إلى نار صغيرة ولهب مشتعل، وعندها يدسّ هذه “المشعل” تحت هرم القشّ والحطب والربد، و”تسوق” النار في الهرم، وتروح تنتشر فيه “كانتشار النار في الهشيم”، وما هي إلا دقائق معدودة حتى يصبح اللهب بطول قامات الرجال…
ويصطفّ الشباب عند ذلك “مثل صفّ العسكر”: الواحد بعد الآخر، ويقتربون ركضاً من “الأبيلة، ثمّ يقفزون من فوق اللهب، أما الصغار فكانوا يقفزون بمحاذاة “الأبيلة”، أو من فوق جانب من جوانبها لم يرتفع لهيبه كثيراً.
وكان القافزون يرددون بأصوات مرتفعة:
الليلة عيد الصليب
وشايشن فيّ ايطيب!
(أي: الليلة يصادف عيد الصليب، وأيّ شيء فيّ يطيب ويُشفى!)
وكانت السنة اللهيب الطويلة “تداعب” غرر الشباب القافزين، فـ”تقبّل” غرّة هذا، و”تلعق” غرّة ذاك، وتكون النتيجة أن “يعبق” الجو برائحة شياط الشعر المنبعثة من الغرر المحترقة، والدخان الكثيف الذي يغطّي كل ما حول الأبيلة”.
وكانت السعادة ترقى إلى مستويات لم يعهدها الناس من ذي قبل.. .وكانوا كلّما وهنت نار “الأبيلة” وخارت قواها وضعفت ألسنة اللهب يرفدونها بكميات أخرى من القشّ والحطب والربد.
أما العجائز فكنّ ينتظرن حتى تنطفئ “الأبيلة” نهائياً تقريباً، فيأتين بمواعينهنّ مملوءة بالماء، ويقمن بتسخين الماء على ما تبقى من “رمس” أو “رمض” وهو الرماد الساخن والجمر الصغير جدّاً الذي ظلّ فيه، الذي خلّفته نار “الأبيلة”، ويغسلن وجوههنّ بهذا الماء الساخن فيما بعد، فهو يشفي من الأمراض ويقي من الأسقام.
ويقوم آخرون بدسّ حبّات البطاطا في “الرمض” لشوائها…
ويفاخر كلّ واحد ب”أبيلته”، فإلى أيّ مدى ارتفع لهيبها، وإلى أين كان يمكن مشاهدة نارها، وكم من الوقت دام اشتعالها…
وكل عام والجميع بألف ألف خير!